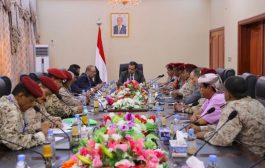محمد علي محسن
اطلعتُ اليومَ على كتابٍ أصدرته مؤسسة أمجد الثقافية والحقوقية؛ لإحياء قضية الشهيد أمجد محمد عبد الرحمن، الناشط المدني الذي اغتالته رصاصة الإرهاب ليلة ١٤ مايو ٢٠١٧م.
الكتابُ تذكاري، وغايتُه التوثيقُ للجريمة المستمرة، وإحياء ذكراه السنوية، وقد كُرِّسَت مادته لمناهضة العنف والتطرف، والنصرة لحقوق الإنسان، ومن أجل قيم الحرية والعدالة والمدنية في اليمن.
نعم، اغتُيل أمجد، ابن مدينة عدن، الحالم بوطنٍ تسوده الدولة المدنية والقيم الإنسانية. كان شابًا طموحًا متعدد المواهب، جمع بين الدراسة الأكاديمية في الحقوق والنشاط الثقافي والحقوقي المتميز.
جريمةٌ ينبغي أن تكون قضية رأي عام، ولا تقتصر على جماعة حقوقية أو ناشطين أو أقاربه. فالمتهمون جماعة ظلامية تكفيرية خطرة، ومهددة للسلم الأهلي والاجتماعي، واغتالت الشاب بدم بارد بسبب آرائه ومعتقداته الفكرية، ونشاطه السياسي والحقوقي والثقافي والتنويري.
لم تكن جريمة الاغتيال مجرد حادث عابر، بل كانت مدبرة بدقة، بسبب آرائه الفكرية التنويرية التي تتعارض مع الأفكار الظلامية، ومع نشاطه الثقافي والحقوقي من خلال تأسيسه “نادي الناصية الثقافي”، وكذا مواقفه السياسية المناهضة للتطرف والداعية للدولة المدنية، ودفاعه عن الحريات، وخاصة حرية التعبير والفكر والمعتقد.
وما هو معلوم وموثق أنه في ليلة الرابع عشر من مايو عام 2017م، اقتحم مسلحون ملثمون يرتدون الزي العسكري مقهى للإنترنت في مدينة الشيخ عثمان بعدن، حيث كان أمجد جالسًا، وأطلقوا النار عليه أمام أنظار الحاضرين، مما أدى إلى استشهاده على الفور.
تميز أمجد بإيمانه الراسخ بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية، وكان مؤمنًا بحتمية التطور والانحياز للأفكار العظيمة التي ترفع من شأن الإنسان والوطن.
الشاب درس الحقوق، وكان شعلة من النشاط والإيمان بحتمية التطور والانحياز للأفكار العظيمة، واغتيالُه جريمة إرهابية، رصاصها لم ينَهْلِ على جسد أمجد الشاب المكافح الحالم فقط ، وإنما طال قلب شعب ووطن ودولة.
قهر أن يُغتال إنسان مدني لمجرد الاختلاف معه في الرأي والفكر، وأفظع من الجريمة هو الصمت المخزي. كيف اغتيل؟ وكيف أن القتلة ما زالوا طلقاء دون عقاب أو حتى محاكمة؟
أما أفضع ما في الجريمة، أنها لم تقتصر على لحظة الاغتيال، وإنما تبعتها سلسلة من الانتهاكات التي لم تشهدها القرون الوسطى ، ووصل الحال بالإرهابيين إلى أن منعوا الصلاة عليه، وأن يرفضوا دفنه في مقابر المسلمين بذريعة أنه ” ملحد ” .
ومُنع العزاء، ومُنعت أسرته من استقبال المعزين وإقامة مراسم العزاء، واعتقل ثلاثة من أصدقائه الصحفيين أثناء تقديم واجب العزاء وعُذِّبوا، وهددوا ناشطين آخرين بالقتل والتصفية الجسدية.
كيف لعائلته، لوالديه وإخوته؟ كيف لأصدقائه وزملائه أن يتحملوا كل هذه المأساة، وكل هذا القهر؟ .
الجريمة تم توثيقها لحظة بلحظة، وتناولتها التقارير الدولية، وأشارت صراحة إلى تورط عناصر من معسكر ٢٠ يونيو في كريتر.
كما وأدانتها منظمات حقوقية محلية ودولية وطالبت بالتحقيق العاجل، إلا أن كل هذه الإدانات والمطالبات ذهبت أدراج الرياح، وقوبلت بصمت متعمد من بعض الجهات السياسية وسلطات الأمر الواقع.
اغتيال أمجد لم يكن مجرد جريمة قتل، بل كان هجومًا على قيم الإنسانية جمعاء، واستهدافًا صارخًا لكل من يحلم بعالم أفضل. إن استمرار إفلات القتلة من العقاب بعد أكثر من ثماني سنوات هو جريمة مستمرة تضيف إلى المأساة الإنسانية أبعادًا أكثر قتامة.
وتبين لاحقًا أن القتلة ينتمون إلى قوات “الحزام الأمني”، فكيف لجهاز أمني مهمته صيانة الحقوق وحماية الأفراد أن يقبل بوجود عناصر إرهابية متطرفة في عداد قوته؟ وكيف له أن يتستر على قتلة معروفين بأسمائهم وصفاتهم؟
مرت ثمانية أعوام على جريمة اغتيال أمجد، دونما قبض أو عقاب للجناة، وهذا يدعونا للتساؤل عن سبب واحد وجيه لتقاعس الأمن والقضاء عن ملاحقة الجناة رغم معرفة أسمائهم ووجودهم.
أدعو كل إنسان حر ومخلص وصادق إلى نصرة الحق ورفض الظلم الجائر، فليس هناك ما هو أفضع من الصمت إزاء إزهاق روح إنسان، ومنع أهله من دفنه أو إقامة عزاء، وتهديد أقاربه وأصدقائه بالتصفية في حال شهدوا أو لجأوا إلى سلطات الأمن والقضاء.
أين القضاء؟ وأين أجهزة الأمن؟ وأين العدالة؟ ولماذا القضية عالقة منذ ثمانية أعوام ونيف؟ جريمة اغتيال مشهودة وأطرافها معروفة، فمن ينصف أمجد الشهيد المغدور؟ ومن ينصف عائلته التي ذاقت مرارة القسوة والخوف والحزن؟!
في أي غابة نعيش؟ وكيف لثلة متطرفة أن تستبيح نفسًا معصومة وتروّع المواطنين الآمنين؟ وأين هي قوات مكافحة الإرهاب من جريمة مروعة أدانتها السلطات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية؟!