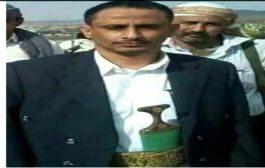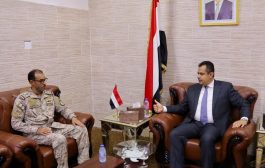أمين اليافعي
كاتب يمني
أدّت وتيرة الأحداث والتحولات التي شهدتها المنطقة طيلة الشهور الماضية، إلى شيوع اعتقاد لدى طيف واسع من الخبراء والمحللين مفاده أنّ تأثيرات هذه الأحداث ستقود حتماً وبالضرورة إلى كثير من التحولات، وعلى مستويات عديدة ومتشابكة في الوقت نفسه: محلية، وإقليمية، ودولية، وفي أبعادها الشاملة: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.
ومِمّا لا شك فيه أنّ هذه الأحداث وتداعياتها ستترك تأثيرات واسعة النطاق من زاوية تحليلها وفقاً للحسابات والاعتبارات الكمية، على الأقل، لكن فيما يتعلق بمعيار الكيف، أي مضمون هذه التحولات وطبيعة نتائجها، تبقى الكثير من الأسئلة الرمادية والسوداء تتصاعد كمثار نقعٍ في فضاءات التحليل والتفكير.
لقد ظل هذا الشرق الأوسط التقليدي والعتيق في بنيته وجلّ مُخرجاته يمُرُّ منذ أعوام طويلة من خلال بابٍ دوّارٍ (revolving door) لمشاريع دولية غالباً ما رَفَعَت شعار الشرق الأوسط “الجديد”.
أبناؤه الذين قرروا الوفاء الصميم للماضي لتأكيد أصالة ما تاركين ممكنات العصر الحديث وروافعه، يجدون أنفسهم في كل مرّة وهم يخرجون من إحدى فتحات الباب الدوّار، وفي كل مرة لن يُقابلوا بـ “شرق أوسط جديد” بمعنى العصرنة والحداثة والتطور، بل في خِضم حالة شرق أوسطية جديدة شكلاً، لكنّها أكثر تقليدية وعتاقة وتخلفاً واضطراباً من حيث المضمون.
واليوم والشرق الأوسط يُعاود محاولات تشكّله بالآليات والأدوات والكيفيات نفسها، من المهم الوقوف على المعطيات المتفرقة، والعوامل المتعددة، والمسارات المتقاطعة التي أدّت في كل مرّة إلى التمهيد لحدوث طوفان من الانهيارات الواضحة، وتتابع سلسلة من الولادات العسيرة والغامضة، للاقتراب من محاولة فهم أشمل لطبيعة الزمن التكراري الذي يُعاد إنتاجه في كل مرة.
البدايات الغامضة
في خضم كل التحولات التي مرّت بها المنطقة، من الصعوبة بمكان الإمساك بنقطة بداية يؤسس عليها التحليل انطلاقته الواثقة، لكن بمناسبة التطورات الأخيرة يمكن اعتبار العام 1979 إحدى النقاط الرئيسية في مسار هذه التحولات.
فقد صعد نظام الملالي في إيران في ذروة الصراع بين المعسكرين الغربي والشرقي، ومع أنّه رفع يافطة “لا شرقية ولا غربية”، لكنّ علاقته بالمعسكرين ظلّت لأعوام محفوفة بالتقلبات والمفاجآت.
تدهورت العلاقات الإيرانية الأمريكية بسبب دعم أمريكا لنظام الشاه الذي تمّت الثورة عليه، وخسارة أمريكا لواحد من أهم حلفائها في المنطقة.
ومع الاختلاف الإيديولوجي الشاسع بين الاتحاد السوفييتي والنظام الجديد في طهران؛ وهو بالمناسبة النظام الديني الوحيد الذي ربطته علاقة بالمنظومة الاشتراكية، فرَضَت تقاطعات كثيرة قيام علاقات من نوعٍ ما (الصراع الدولي مع المعسكر الغربي ومواجهات الجماعات السنّية الجهادية في أفغانستان)، لكنّ هذه العلاقات ظلّت متقلِّبة المزاج على جمر الحرب العراقية الإيرانية.
بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، ورسو النظام الدولي على قطب واحد، حاول أن ينتدب نفسه لمهمة ختم التاريخ البشري عن طريق فرض نموذجه في العالم وبالاستفادة من الحقبة العولمية التي عَمِلت على توهين صلابة السياجات القومية، انتشرت في الفترة نفسها الجماعات الجهادية وحركات الإسلام السياسي وكانت أشبه بالجراد التي وصفها يوسف زيدان في رواية “عزازيل” (تأكل كل ما هو يانع في المدينة، وتملأ الحياة كآبةً وقسوة). بعد ما سُمّي بـ “النكسة”، وتراجع تأثير الأحزاب التقدمية والليبرالية لصالح صعود نجم التيارات الإسلامية السياسية والجماعات السلفية، والفشل في مشاريع التنمية والتحديث، وتفشي الفساد وسوء الإدارة، بالتوازي مع ازدياد أفواج المهاجرين فكرياً إلى أصقاع الماضي ـ وليس التيارات الدينية فقط هذه المرة، وإنّما أقطابُ الفكر والفلسفة المعاصرون ـ باعتبار الماضي المصدر الوحيد لإمكانية العثور على خلطة (سحرية) أصيلة لإحياء عظام المستقبل العربي.
وقد أدت الصراعات الذاتية المستطيرة بين النخب الليبرالية والقومية إلى تعطيل نمو وتطور العمل المؤسسي فأوقع كينونة “الدولة الوطنية” في حالة هشاشة وإعاقة مستدامتين ممّا جعلها، وعلى الدوام، عرضة للارتجاجات والاهتزازات عند أبسط التحديات أو المنعطفات.
كل هذه العوامل مهدت الطريق لبروز عصر الجماعات الإسلاموية العابرة لكل الحدود، والمفارقة غير المتوقعة خصوصاً من زاوية القراءة الاستشرافية المؤمنة بالتقدم الحتمي في حركة التاريخ هي أنّ الحركات الإسلاموية ستكون أكثر من يستفيد من الحقبة العولمية في بداية تدشينها.
كانت العولمة ـ بالنسبة إلى غالبية الدول العربية ـ استكمالاً لسلسلة الصدمات الحضارية والتحديات التي لا قِبل لها بمواجهة طوفانها، ولكن هذه المرّة لم تكن ناتجة عن الاحتكاك المباشر بالأدوات والتقنيات الاستعمارية المتقدّمة التي أزالت الحدود على الأرض، وحاولت أن تنتزع مفاتيح السيادة الوطنية وأهلية وجدارة أصحاب الأرض في حكم أنفسهم ومكانة تراثهم الثقافي في الحضارة المعاصرة، بل هذه المرة عن طريق عمليات وآليات لا يتم إدراكها بسهولة، لكنّها تنتقل بشكل تلقائي وبسرعة البرق، وتأخذ ما تريد، مخترقةً كل التحصينات حتى تلك التي لم يستطع الاستعمار التقليدي الوصول إليها.
وفي ظل الحالة النفسية والذهنية لتلك الفترة التي ساد فيها ما سمّاه فتحي المسكيني بـ “الكوجيطو المجروح؛ ذلك الانتماء المُعطِّل والجاهز للاستعمال العمومي من قبل طفيليات سياسية في وضع اللا-دولة”، تفاعلت تيارات الإسلام السياسي والجماعات الدينية والصحوية مع هذه الحقبة بنهجين متناقضين تماماً؛ فهي حاولت استثمار الأدوات والتقنيات التكنولوجية ووسائل الاتصال الحديثة، وبأقصى حد ممكن للوصول إلى كل مكان على الكوكب، مستفيدةً من ميّزة خِفتها في الحركة بكونها جماعات ما دون دولة (جمعيات)، وفي الوقت نفسه ما فوق دولة (شبكات عابرة للدول)، وقد أسهم الاستقلال الوطني وقيام الدول الحديثة في العالمين العربي والإسلامي من تقييد حريّة حركتها لفترة من الزمن، فوجدت في العولمة باعتبارها خروج السياسة من السكّة التقليدية للدولة الوطنية فضاءً مفتوحاً للسفر بحرّية إلى وعي المسلم في كل مكان في محاولة لإعادة إحياء مشاريع الخلافة والدولة الإسلامية.
ومع أنّها كانت جماعات ذات خطابٍ تقليديٍّ بحتٍ، إلا أنّها سيطرت على وسائل الإعلام والتواصل الحديثة، وبشكل ملفت.
من جهة أخرى، حاولت أن تُقدِّم نفسها باعتبارها السور الثقافي والهوياتي المنيع الذي يقف في وجه العولمة الثقافية، وهي بالتالي المسؤولة الوحيدة عن حقن المسلم (المجروح هوياتياً) بلقاحات الحماية اللازمة ضد ما اعتُبر فيروسات ثقافية، بغضّ النظر عن جنسيته أو البلد الذي يُقيم فيه، ولهذا شهدنا للجماعات الدينية حضوراً لافتاً وسط الجاليات المسلمة في الدول غير الإسلامية.
بدأت هذه الحقبة بالتحالف النفعي المؤقت بين أمريكا والجماعات الجهادية لمواجهة العدو المشترك (المنظومة الاشتراكية /الشيوعية). وفي لحظة سقوط الأخيرة زادت شعبية النموذج الأمريكي في العالم باعتباره النموذج الأكثر استدامة حضارياً لامتلاكه كل عناصر القوة والتفوق، ممّا حفز الأمريكان للسعي إلى فرضه على العالم.
في السياق العربي الإسلامي المضطرب بين انتماءات مختلفة، ازدادت شعبية الجماعات الدينية، حتى الجهادية منها، وقد كانت المهمة الجديدة المنتدبة هي مواجهة مشروع “الأمركة”، بالتوازي مع ضرورة تطهير العالم الإسلامي من “الجاهلية الثانية”.
وفي هذه المعمعة، وبعد انهيار المعسكر الشرقي، انحسر أفق التفكير والتعلُّق سواء بمشروع الدولة الوطنية (القُطرية) أو العمل العربي المشترك في وعي الإنسان العربي لصالح أولويات أخرى، وهذا الوعي بأهمية مشروع الدولة الوطنية والوحدة العربية هو بالمناسبة وعيٌّ مُستحدثٌ وطارئٌ نظراً لهيمنة منظورات الرؤية الدينية التقليدية.
ولا شك أنّ الإنسان العربي الذي وجد نفسه في مقاومة محتومة (سياسية وثقافية تحديداً) مع المشاريع الاستعمارية بكل تجاليتها ونسخها وصولاً إلى الارتدادات الدائمة والمؤلمة لملف القضية الفلسطينية النازف، وَجَد في التوازن القطبي الذي فرضه المعسكر الشرقي ركيزة مهمة للجرأة على اجتراح مشاريع (تقدميّة) تخففت كثيراً من النزعة الدينية.
تحولات مستطيرة
فتَحَت أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) الإرهابية العالم على مصائب ومسارات لم تخطر على بال، وبالنسبة إلى كثيرين حول العالم كانت الصورة واضحة وصادمة، وعلى الهواء مباشرة، وبدا كأنّ فرضية “صراع الثقافات /الحضارات” تحققت بسرعة البرق وبأكثر الأشكال الواقعية والفنتازية رُعباً.
تنوّعت الآراء من الحادثة في الأوساط العربية بين التنديد والتحذير من صعود خطر الجماعات الجهادية، إلى الفرح الذي ساد بين أوساط بعض التيارات الإسلامية إذ رأت في هذا السقوط المدوي لبرجي التجارة العالمية، وهما رمزان مهمان، عملاً بطولياً وملهماً، أمّا الدول العربية، فقد كانت طوال الوقت بحاجة إلى تبرير مواقفها.
كانت الولايات المتحدة القطب العالمي الأوحد المُهيمن، وتمرُّ في عزّ فترة زهو ونشوة الإحساس بالإمساك بخطام التاريخ، وكانت الحادثة ضربة مزلزلة لصورتها.
ساد حينها الاعتقاد بأنّ السلام والأمن لم يعودا متناسبين مع وجود بؤر صراع مختلفة في العالم، وعدم كفاية الالتزام والحضور الأمريكي حيال ذلك، لكنّ الاستراتيجية التي تم تطويرها للتعامل مع تبعات هذا الحدث الكبير كانت شديدة الغرابة وحافلة بالتقلبات والتناقضات.
منذ تلك اللحظة، دخل العالم حقبة ما سُمّيّ بـ “الحرب على الإرهاب”، وكان من الطبيعي أن تَحشِد الولايات المتحدة دول العالم خلفها للذهاب إلى ضرب مركز التنظيم الإرهابي في أفغانستان. على أنّ الرأي الذي تشكَّل في أمريكا في تلك الفترة ـ وفقاً لأولريش بيك ـ هو أنّه لكي يتسنّى للأمريكيين العيش بأمان وفي عالم معولم لا حدود له فإنّ الحل الجذري يكمن في السعي إلى “أمركة العالم” بطريقة أكثر تصميماً وأكثر فاعلية، أي تنميط العالم كله على صورة القيم الأمريكية، والحياة الأمريكية. من هذه الزاوية وحدها نستطيع أن نستشف جانباً من حيثيات القرار الذي اتُخِذ في دوائر صنع القرار الأمريكية بغزو العراق وإسقاط نظامه.
كان النظام العراقي علمانياً في وجوه كثيرة بالرغم من كل أخطائه، وضد الجماعات الدينية، لكنّه كان ضمن اللائحة الأمريكية للدول المصنّفة بـ “المارقة”.
نتائج هذا القرار كانت أشبه بزلزال شديد ضرب كل مرتكزات وأركان البلد والمنطقة، وهو القرار الذي لم يستطع أحد في المنطقة استيعابه إلى حد اللحظة، فقد كان خروجاً كليّاً عن النص، وانقلاب على مشروع “الحرب على الإرهاب”، إذ وفر بيئة مواتية لانتعاش كل أشكال وأنواع الجماعات الإرهابية.
مرّت إيران بفترة نقاهة طويلة في عقد التسعينيات، أو فترة ما يُعرَف بـ “الكمون الاستراتيجي”، حيث ركّزت على مشاريع إعادة الأعمار وبناء قدراتها الذاتية خصوصاً في المجال العسكري، وعَمَدت إلى خفض وتيرة صخب الشعارات الثورية لصالح الاجتهاد في فتح قنوات دبلوماسية.
ومع وصول الإصلاحيين إلى الحكم بقيادة محمد خاتمي، بَدَت توجهات السياسية الإيرانية الخارجية تجاه دول الجوار ـ تحديداً ـ مختلفة النبرة، وظهر إلى السطح مشروع “حوار الحضارات” الذي بدا كبديل أنيق وكتوجه مناهض بشدّة لفكرة “صراع الحضارات”، الفكرة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط العربية والإسلامية.
لكنّ الأهم من كل ما كان يدور على سطح المشهد هو أنّ دوائر صناعة القرار داخل المؤسسات العميقة لنظام الملالي تفرغت كليّاً لبناء استراتيجية أمنية شاملة تستثمر كل الفرص المتاحة للتوغل داخل ملفات المنطقة وسياجاتها الأمنية لرسم الخطوط المتينة لأمنها القومي، وكان القرار بإنشاء الذراع الخارجية المسؤولة عن العمليات العسكرية والأمنية في المنطقة ضمن الحرس الثوري (قوة القدس) وتطوير قدرات حزب الله العسكرية والتنظيمية والإعلامية في صُلب هيكل هذه الاستراتيجية متعددة الأبعاد، والتي أخذت أشكالاً متدرجة: المضي قُدماً في المشروع النووي، وتطوير صناعة الصواريخ، والدبلوماسية المراوغة، والتحالفات المتنوعة القائمة على مناهضة نظام القطب الواحد، وتكريس النزعة الطائفية، وشبكة الوكلاء، واستخدام القوة العسكرية غير المباشرة (حروب الوكلاء).
كان الموقف الإيراني من ضرب أفغانستان والعراق مفاجئاً، فالتعاون غلب المعارضة المتوقعة المبنية على المخاوف البديهية من اقتراب عدوها أو ما تُسمّيه بـ “الشيطان الأكبر” من حدودها، وملاصقته لها.
ربما قرأ النظام الإيراني أنّ النَفَس الأمريكي من التواجد العسكري الطويل في الخارج قصيرٌ للغاية، وفي كل المحطات التاريخية كانت تدور نقاشات حادة في الداخل الأمريكي حول الموقف من التدخلات الخارجية، أبرزها ما دار حول الموقف من التدخل في الحربين العالميتين الأولى والثانية.
من وجهة نظرتها الاستراتيجية الطويلة والقائمة على بُعدٍ عَقَديٍّ بحتٍ، وجَدَت إيران في إزاحة كماشتين إيديولوجيتين معاديتين تُحيطان بها (سلفية وقومية عروبية) فرصة لا تُقدَّر بثمن.
استثمرت إيران المخاوف لدى الجماعات الشيعية في البلدان العربية إثر الخطاب السلفي المتطرف الذي ساد في تلك الفترة لبناء شبكات متينة الولاء من وكلائها، وكيّفت السياق العولمي وممكناته في تسهيل وتعزيز حرية الحركة وانتقال الأفكار بين الثقافات بسرعة كبيرة في بناء منظومة شاملة تنتقل من خلالها الميليشيات وأفكارها بحرّية وسلاسة.
عربياً كان حزب الله هو درة التاج لهذه المنظومة، خصوصاً بعد الحرب مع إسرائيل العام 2006. كان زعيم الحزب يُقدِّم صورة مختلفة عن صورة زعماء الجهادية الطاغية في تلك الفترة والمتطرفة في خطابها تجاه المجتمع والحياة الاجتماعية بشكلٍ عام، فضلاً عن محاولته لبناء خطاب لا يُشبه الخطابات الدينية التقليدية، خطاب التقت فيه كل المشارب المتطلعة بعنفوان إلى سماع صوت مقاومة مدوٍّ عابر لكل الحدود، وكانت القضية الفلسطينية دائماً في قلبه.
ولولا التجربة الكارثية في سوريا التي أعطت صورة حقيقية عن الطبيعة الطائفية والعنيفة للحزب، وأفقدته شعبيته، لربما كانت المنطقة الآن في نقطة مختلفة ومسار مختلف تماماً.
وإذا كانت الحقبة العولمية قد سهّلَت نشوء وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول، ونشوء التكتلات الإقليمية شرقاً وغرباً، فقد دشَّنت المنطقة العربية هذه الحقبة بالغزو العراقي للكويت، الحدث الذي ضرب فكرة إمكانية تطوير العمل العربي المشترك في الصميم.
ومع استمرار الخلافات والصراعات البينية وسوء أداء النُخب، ظل التساؤل لدى المواطنين في كثير من هذه الدول حول مدى قدرة الطبقة السياسية والفكرية القائمة على مواجهة التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة يأخذ أشكالاً وأبعاداً مختلفة.
وقد كان هذا القلق هو المادة الخصبة التي اشتغلت عليها شبكات إعلامية ضخمة تم إنشاؤها في تلك الفترة وفرضت نفسها عبر الحدود الوطنية لإفراغ ما تبقى في الكأس من أيّ ثقة أو رهان على أيّ جدارة حتى يتسنى سحب البساط كليّاً من تحت أقدام النُخب الليبرالية والقومية القائمة، فتندفع التيارات الإسلامية إلى المجال العام من كل حدب وصوب.
والشرق الأوسط، وفي قلبه الدول العربية، وهو يقف على تقاطعات هذه المسارات الزلِقة، تضافرت عدّة عوامل: الإرهاب والحرب في أفغانستان والعراق بكل إخفاقاتها، ضمان مصالح أمريكا وإسرائيل الاستراتيجية، والخوف الشديد من زحف الصين الواثق، والثقة الزائدة بالقدرة على تغيير كل مسارات التاريخ… دفعت صانع القرار في أمريكا إلى تبنّي مشروع خلق شرق أوسط “جديد”.
كانت التحولات السياسية في كثير من بلدان أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية، فضلاً عن تجارب بعض الأحزاب الإسلامية في الدول العلمانية إلى تبنّي فكرة أن تتم صناعة “إسلام ديمقراطي” خاص، خصوصاً لدى نخبة الحزب الديمقراطي.
وحاولت اللوبيات العمل على إقناع صانع القرار بأنّ هذه الفكرة يمكن أن تُلبّي مطلبين استراتيجيين مُلحين: سيظل الدين الإسلامي المُعين الرئيسي الذي يُشكِّل منظورات الناس في هذه المنطقة من العالم، وبالتالي لا بدّ من صناعة “نموذج إسلامي” يؤمن بالديمقراطية وقادر على سحب البساط من تحت الجماعات الجهادية، وهذا النموذج بإمكانه أن يتكامل لتشكيل تكتل سياسي (عقائدي) أكبر لمواجهة الاجتياح الصيني الناعم. على هذا الأساس، وعلى الرغم من كل التحذيرات، تم دعم التيارات الإسلامية أثناء التحولات التي جرت في عدد من البلدان العربية بداية من العام 2011، ودون دراسة حقيقية لهذه التيارات: فالتحولات في أوربا الشرقية وأمريكا اللاتينية كانت تقودها تيارات تؤمن بالدولة الوطنية، كما أنّ الأحزاب الإسلامية في الدول العلمانية مختلفة كثيراً في أهدافها ونشأتها وخبراتها وطبيعة عملها، وهي محكومة بشروط دستورية صارمة حتى سُمِح لها بالعمل في الشأن العام، بينما تيارات الإسلام السياسي اعتمدت على العمل السرّي وشبكة الجمعيات، ولديها تجارب سيئة، ورؤى متطرفة تجاه المختلفين معها عقائدياً أو سياسياً أو فكرياً، ورافضة لنمط الحياة الاجتماعي القائم، وهي أيضاً لم تكن المعارض القوي والمنظم في وجه الأنظمة السياسية كما تمّ الترويج له، بل كان خطابها معادياً للدولة بسبب “غيريتها الثقافية”، كما تنبّه نزيه الأيوبي منذ وقت مبكر، وكانت تعتقد أنّ الفرصة سانحة بعد سقوط الأنظمة لإعادة تأسيس الدولة من جديد على نمط إسلاميّ بحت وتفكيك كل مؤسسات الدولة القائمة.
غزو العراق 2003 فجّر المنطقة وأعاد إنتاج بيئات خصبة للجماعات المتطرفة، منتهكًا ركائز الدولة الوطنية ومضاعفًا الفوضى
كانت التبعات مُرعبة في أرجاء الوطن العربي كله، فانتشر الصراع الطائفي بصورة لا نظير لها، وتوسع نشاط الجماعات الإرهابية بشكل لافت، الجماعات التي استقطبت أعداداً مهولة من الجهاديين ممّن تمّت تربيتهم في مختلف دول العالم، وليس في الدول الإسلامية فحسب، وكما حدث في الحالة الأفغانية، وهذا يعني الكثير في عصر العولمة، وتداعيات ذلك في المستقبل. لكن أيضاً المفارقة أنّه على الرغم من الصراع الطائفي الشرس والمستطير بين التيارات الإسلامية (السنّية والشيعية) في أكثر من جبهة، حرصت هذه التيارات على إيجاد نقاط أو مناطق التقاء لتبادل الأدوار من خلال خطاب يبدو مُوحداً في ظاهره، خصوصاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
الخواتم المفتوحةٌ على كل الاحتمالات
لم تُطوَ صفحة الحرب على الإرهاب بعد، ومع ذلك عادت طالبان إلى استلام السلطة وفق اتفاقيات جديدة بعد مغادرة مفاجئة للقوات الدولية وهروب مذل للحكومة المدنية المدعومة من الخارج. الحالة السورية التي حفّزت المخيال الجهادي (العالمي) على مدى عقد كامل إلى إعادة تكرار التجربة الأفغانية، وَجَدت في “جبهة تحرير الشام” واجهة جديدة لإدارة وتنسيق مجموعة معقدة ومتشابكة من المصالح الدولية، وقد كان هذا كفيلاً بحصولها على أسرع غفران في التاريخ السياسي مع الاكتفاء بإعلان التهديد بحق النقض في حال تم تجاوز الخطوط المرسومة بدقة صارمة.
إنّ كرة الثلج التي تدحرجت منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) ما زالت هي الأخرى تُراوِح بين منازل كثيرة وغير واضحة المعالم والحدود والنهايات.
فإسرائيل التي شنّت على إثرها هجوماً إقليمياً هدّت فيه حيل تهديدات حزب الله عليها، ووَجَّهت ضربات موجعة للنظام الإيراني مستعرضة قدراتها العسكرية والتقنيّة والاستخبارية، ما زالت تُطالب العالم بالتوسّط لدى حماس لكي تقوم بتسليم سلاحها وإطلاق سراح الرهائن.
الجرح الفلسطيني ما زال ينزف بغزارة، ولا أمل بحلٍّ عادلٍ للقضية الفلسطينية يلوح في الأفق، وهي حالة مكثفّة للاستمرار في شحن المخيال الإسلاموي على الدوام بديناميت التطرف بناء على تركيبة معينة تقوم على ثنائية المظلوميّة /المؤامرة، ولتسويق المشاريع المحمولة على وعود النصر الإلهي للحصول على حقٍ مفترضٍ في التمكين.
لم تنته قصة حزب الله تماماً، وما زال يُشكِّل عائقاً كبيراً أمام تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية، وفاعلية تواجدها وحضورها على أرض الواقع.
نظام الملالي الذي طوّر آليات واستعدادات شديدة المرونة بفعل خبرات وتجارب طويلة مكنته من السكون والكمون وإعادة الانبعاث حتى تحين لحظته وَجَد في هذه الحالة العالقة تخريجة جيدة لابتكار التفسيرات والتأويلات والانتصارات المتوهمة، وبما يعيد هو الآخر شحن “سردية الحسين” القائمة أيضاً على ثنائية المؤامرة /المظلومية على أكمل وجه، ولا يبدو أنّ هنالك أملاً كبيراً لإحداث تغييرٍ من الداخل نظراً للمخاوف الكبيرة من أن تَعُم الفوضى.
وكل هذه التحولات الواقفة على قدمٍ واحدةٍ ما زالت تنتظر تفعيل عصا المفاوضات السحرية لساكن البيت الأبيض!.
إنّ وضع كل هذه المعطيات في الاعتبار، وعلى ضوء التحولات الكبرى في العالم، وحركة التاريخ، يجعلنا أمام حالة يَصْعُب تحليل ديناميات تحولاتها والتنبؤ بنتائجها، وربما هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تُفاجئنا في كل مرّة بما لا يخطر على بال، لدرجة أنّ الآلية التي يتشكّل بها مستقبل الشرق الأوسط في ظل هذه الشروط، إن جاز تشبيهها، هي أقرب إلى طريقة كتابة الرواية الحديثة ذات النهاية المفتوحة على كل الاحتمالات.
وعلى كل قارئ الاجتهاد في إنتاج نهاية لروايته الخاصة، ولكل خاتمة مداها وخطوط متغيّرة بين مدٍّ وجزرٍ، وينبغي عليها أيضاً أن تتعايش، بسلامٍ أو بقليلٍ منه أو بدونه، مع كل ما ينتجه الآخرون من نهايات مؤقتة أو دائمة، واقعية أم متخيّلة، دولتية أو ما دون دولتية (ميليشياوية، طائفية، إثنية، قبلية)، وما فوق دولتية (إقليمية ودولية)، والتي ستُشكِّل في كلّ مرّة، وبمجموعها وبعلاقاتها المتداخلة والمتقاطعة، صورة الشرق الأوسط القديم /الجديد.
المصدر : حفريات