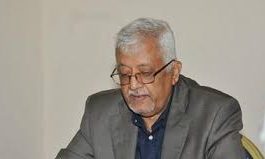عماد عبد الحافظ
كاتب مصري
بعد سجالات وخلافات بين الأزهر ووزارة الأوقاف تمّت الموافقة من جانب البرلمان مؤخرًا على قانون لتنظيم الإفتاء، وقد حدد القانون الجهات التي لها حق إصدار الفتاوى العامة والخاصة، حيث قصر حق إصدار الفتاوى العامة على هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية التابعين للأزهر ودار الإفتاء، أمّا الفتوى الخاصة فقد منح الحق، بجانب الجهات الثلاث السابقة، إلى لجان في المحافظات تتشكل من أعضاء ممثلين للأزهر والإفتاء والأوقاف وذلك بعد اجتيازهم للشروط الموضوعة في القانون والحصول على ترخيص من الأزهر بذلك، والأهم في القانون هو تجريمه لفعل الفتوى دون ترخيص لمن لا ينتمي للجهات السابقة، حيث نص على عقوبة جنائية لمن يتصدر للفتوى تتمثل في الحبس والغرامة.
وتسعى المؤسسة الدينية الرسمية من تنظيم الفتوى على هذا النحو إلى ضبط عملية الإفتاء ومواجهة ما سُمّي بـ “فوضى الفتاوى”، لكنّ السؤال هنا هو: هل يُسهم القانون في مواجهة فوضى الفتاوى بالفعل، وهل يؤدي على الجانب الآخر إلى مزيد من الجمود في الفكر الديني من خلال الإغلاق النسبي لباب الاجتهاد واحتكار الفتوى؟
الفتوى بين الفوضى والتوظيف السياسي
هناك الكثير من الفاعلين في المجال الديني يتنافسون فيما بينهم على المكانة وعلى تمثيل الدين واكتساب الشرعية الدينية، فالمؤسسة الدينية الرسمية بمكوناتها المختلفة، والحركات والتيارات الإسلامية، كلّ منهم يرى أنّه هو الذي يفهم الإسلام على وجهه الصحيح، وأنّ له الحق من ثم في الحديث باسم الدين، وقد أسهم الربيع العربي في منح مساحة أكبر للخطاب الديني في الحضور في المجال العام، ومع حالة السيولة التي ترتبت على الثورة؛ اشتدت المنافسة بين هؤلاء الفاعلين حيث سعى كل منهم إلى توسيع المساحة التي يعمل فيها والدور الذي يقوم به والتأثير الذي يحدثه، ومع تزايد القنوات والبرامج التلفزيونية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي؛ ازداد حضور رجال الدين الرسميين أو غير الرسميين في المجتمع، وكثرت الفتاوى التي تُعبّر عن رأي كل مؤسسة أو حركة أو تيار ديني، وأصبح رجال الدين والشيوخ ضيوفًا دائمين على البرامج التلفزيونية وعلى وسائل التواصل، وحدثت حالة من السيولة في الفتوى، وانتشرت بعض الفتاوى الشاذة.
وقد ازداد صراع الفتاوى بعد 2011 مع الخلاف بين التيار الإسلامي والتيارات الأخرى حول هوية الدولة ومكانة الدين في المجال العام، وازداد أكثر بعد 2013 مع تزايد الصراع بين بعض الحركات الإسلامية والدولة، وتم استخدام الفتاوى في كثير من الأحيان كأداة في هذا الصراع من حيث توصيف النظام الحاكم وتحديد آليات التعامل معه، وتبرير العنف ومنحه عمقًا دينيًا من خلال تأصيله تأصيلًا شرعيًا، وذلك جعل المؤسسة الدينية الرسمية ترى أنّ الأمر بحاجة إلى عملية ضبط للفتوى وتحديد الجهات التي لها الحق في إصدار الفتاوى بالشكل الذي يمنع الفوضى ويحافظ على استقرار المجتمع، خاصة في مرحلة تشهد العديد من التحولات في المجال الديني نتيجة المتغيرات التي ترتبت على الربيع العربي؛ ولذلك سعت المؤسسة الرسمية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة تلك الفوضى حسب رأيها، ومن هذه الإجراءات قانون تنظيم الفتوى الذي صدر في شهر أيار (مايو) الجاري، الذي قصر حق إصدار الفتوى على جهات معينة، حيث فرّق بين الفتاوى العامة وهي الخاصة بالقضايا العامة، وبين الفتاوى الخاصة التي تتم بناء على طلب من آحاد الناس، فجعل الأولى من اختصاص هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء، والثانية جعلها من اختصاص الجهات السابقة وأضاف إليها بناء على تعديل القانون لجانًا يتم تشكيلها من أعضاء من الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف بعد استيفاء شروط معينة وتدريبات والحصول على ترخيص بالفتوى، وجعل هناك عقوبة بالحبس والغرامة لكل من يتصدر للفتوى عبر وسائل الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي ممّن ليس لهم الحق في ذلك وفقًا للقانون، وكذلك للمسؤولين عن تلك البرامج أو الصحف والمواقع.
تنظيم الفتوى والجمود الفكري
يحمل النص الديني، في أغلبه، أوجهًا مختلفة ومتعددة للفهم، ويخضع لتفسيرت وقراءات متنوعة تختلف من فقيه أو عالم إلى آخر ومن زمن إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر، ومن هنا تعددت الأفهام وتعددت الآراء والمذاهب الفقهية، وتعرّض الفقه للتطور الذي يميز الحياة بطبيعتها، ولذلك تحدث العلماء عن التجديد في الدين وأنّه أمر طبيعي وضروري.
والقانون المنظم للفتوى في حين يواجه حالة السيولة والفوضى في إصدار الفتوى كما وضحنا، فإنّه على الجانب الآخر يؤدي إلى احتكارها وقصر الاجتهاد على جهات وأشخاص معينين؛ الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الجمود في الفكر الديني في ظل مرحلة تشهد العديد من الانتقادات الحادة أحيانًا لآراء وأفكار دينية مستقرة لكنّها أصبحت في نظر البعض بحاجة إلى التجديد وإعادة النظر والمرونة التي تجعلها قادرة على التكيف مع التطور الحاصل في حركة الاجتماع البشري.
ومن جانب آخر فإنّ هذا القانون، وكما يرى العديد من المفكرين، يحرم الكثير من المتخصصين في الفقه من أساتذة وباحثين من الفتوى على الرغم من كونهم مؤهلين لذلك من الناحية العلمية، ويجعل هناك سيفًا مُسلطًا على رقابهم يمنعهم من الحديث وإبداء الرأي على وسائل التواصل أو في البرامج المختلفة تجاه العديد من القضايا، بل إنّ القانون يقف عقبة أمام الاجتهاد في قضايا مستجدة تحتاج إلى رؤية وقراءة جديدة للنص الديني، ويجعل الرأي السائد فقط هو رأي المؤسسة الدينية الرسمية، وهذا يؤدي إلى الجمود الفكري وإلى تداعيات سلبية خاصة بالحالة الدينية، منها ابتعاد أفراد عن دائرة التدين وعن دائرة الدين بالكليّة.
وفي هذا الإطار تقول الدكتورة زينب أبو الفضل أستاذة الفقه وأصوله بكليّة الآداب جامعة طنطا في صفحتها على موقع (فيس بوك): إنّه وفق هذا القانون لا يحقّ لنا نحن أساتذة الفقه وأصوله، أو العلماء المتخصصين في الفقه والفتوى أن نفتي إذا سُئلنا، ما دمنا لسنا أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية، أو هيئة كبار العلماء، أو دار الإفتاء المصرية، أو في لجان الفتوى التابعة للأزهر الشريف تحديدًا، وهذا معناه أنّ مصر لم تتخلص من روح الإقصاء والاستبداد الديني الذي طالما حاربه المصلحون، مثل الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد منذ أكثر من قرن من الزمان، وكأنّه ما كان ولا كان كتابه، بل سوف نتعرّض نحن أساتذة الفقه وأصوله للعقاب القانوني إن سُئلنا فأفتينا، أو حتى إذا أبدينا رأينا الديني في نازلة من النوازل مثلًا، بينما يحق لتلاميذنا ممّن يعملون بدار الإفتاء المصرية أو بلجان الفتوى التابعة للأزهر، ولاحقًا الأوقاف، أن يفتوا بما يشاؤون، ولو كانوا ممّن يحملون الليسانس فقط، فالمؤهل هو عملهم بهذه الأماكن وكفى، أيّ منطق هذا؟
وبالمناسبة أقول :لقد درس على يدي، وما يزال، عدد كبير ممّن يعملون بدار الإفتاء المصرية، وبمجمع البحوث الإسلامية، كما درس على يدي معيدون ومعيدات بكليات الشريعة والدراسات الإسلامية والعربية، وبكليات أصول الدين وغيرها من كليات جامعة الأزهر، وكذا أعضاء بلجان فتوى بالأزهر وبالأوقاف، وأئمة وخطباء من شمال مصر إلى جنوبها، وقد تم منح كثير منهم الماجستير والدكتوراه تحت إشرافي العلمي، وما يزال منهم من ينتظر، وهؤلاء جميعًا وفق مشروع القانون يحق لهم الفتوى، أمّا أستاذتهم فلا، بل تخضع للمساءلة والعقاب القانوني إن فعلت، يعني ما عليّ إن استُفتيت إلا أن أحيل السائل إلى تلميذ من تلاميذي، الذين أعاني الأمرّين لسنوات قد تمتد إلى عشر، بدءًا من التمهيدي حتى الدكتوراة حتى يكون الواحد منهم في نظري صالحًا لأن يحمل لقبًا علميًا، أو بالكاد يكون قد اقترب من أن يكون مؤهلًا!
المصدر : حفريات