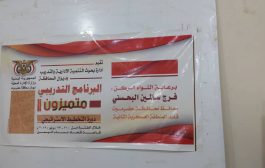محمد الزغول
كرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أطروحته السياسيّة الجديدة “السلام من خلال القوة” كبديل عن المُقاربات التقليديّة للإدارات الديمقراطيّة السابقة (إدارة أوباما، وإدارة بايدن)، والقائمة على نظريات: “إدارة التحالفات”، و”القيادة من الخلف”، و”تشارك أعباء الهيمنة.”
وللوهلة الأولى تبدو أطروحة الرئيس ترامب متعلّقة بمفهوم السّلام الذي يتقدّم ذكره في العبارة/الأطروحة، لكنّ التسرُّع في الأخذ بهذا الاستنتاج سيكون مُضَلِّلًا؛ فأطروحة الرئيس ترامب متعلّقة بمفهوم “القوة” (الكلمة التي ترد متأخرة في العبارة)، وتطبيقاتها في النظرية السياسية الأميركية أكثر من ارتباطها بمفهوم “السّلام” (الكلمة التي ترد أولًا).
إنّ أطروحة الرئيس ترامب (السّلام من خلال القوة) ما هي إلّا تتويجٌ لمسارٍ تاريخيٍّ طويل لتطوُّر “مبادئ القوّة” في الإستراتيجية الأميركية عبر عُقود متمادية من الزّمن.
انطلاقًا من مبدأ “فنّ خلق القوّة” الذي أوضحه أستاذ الإستراتيجيا الكبير؛ لورنس فريدمان في كتابه “تاريخ الإستراتيجية”؛ إذْ عرّفَها بأنها: “فنُّ خلق القوّة، وهو فنٌّ يصعب إتقانه أو الإمساك به.” وهو المبدأ الذي ظلّ سائدًا حتّى مطلع عَقْد الأربعينيات من القرن الماضي، قُبَيْل الحرب العالميّة الثانية.
ثمّ جرى التنظير بعد ذلك لمبدأ “استخدام القوة”، وهو المبدأ الذي تُوِّجَ بإلقاء القنبلتين النوويّتين على مدينتَيْ هيروشيما وناكازاكي في اليابان خلال الحرب العالمية، وأدّى إلى انتهاء الحرب واستسلام اليابان.
وهو ما كان يعني أميركيًّا تحقيق “السّلام من خلال القُوّة.”
وبطبيعة الحال، تغيّرت “بُنية القوة” في المشهد الدولي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وخروج الحلفاء منتصرين.
وفي ظلّ انطلاق مسار “إعادة تشكيل التّحالفات”، وهيمنة “العبء الأخلاقي” لهذا النّصر الأميركي النووي في الوجدان الأميركي والغربي، كان لا بُدّ من ظهور مبدأ جديد للقُوّة في الولايات المتحدة.
وربّما كانت ذلك شرارة الانطلاقة لعصر الإستراتيجية الذهبي للرئيس ريتشارد نيكسون، وهنري كيسنجر اللذين أعادا إحياء مبدأ الرئيس ثيودور روزفلت في مطلع القرن العشرين (تكلّم بنعومة واحمل عصا غليظة)؛ حيث تمّ منح “القوّة الناعمة ” قيمة أكبر في الإستراتيجية الأميركية في عهد نيكسون.
وفي 25 يوليو1969،أعلن نيكسون عن تغييرات في ملامح السياسة الخارجية الأميركية أُطلِق عليها “عقيدة نيكسون”، وكانت تهدف إلى إنهاء الحرب في فيتنام، ومنع اشتعال حروب مشابهة لها مستقبلًا؛ إذ ركّزت “عقيدة نيكسون” على التحوُّل من التدخُّل العسكري المُباشِر في مُساندة حلفاء الولايات المتحدة إلى توجيه الدعم الاقتصادي والعسكري لهؤلاء الحلفاء.
وما كانت الولايات المتحدة لتستطيع الإطاحة بخصم دولي عنيد مثل الاتحاد السوفيتي لولا ظهور مبدأ الرئيس رونالد ريغان حول “القوة الصّريحة” في الثمانينيات من القرن الماضي؛ حيث تمّ من خلال هذا المبدأ جرّ العالم، وعلى نحو أكثر تحديدًا جرّ الاتحاد السوفييتي بشكلٍ مقصود إلى “حرب النجوم”، وسباقات التسلُّح الكبرى التي أثقلت كاهله بأعباء لم يكن قادرًا على تحمُّلها، وأصابه التصدُّع والانهيار على الرغم من امتلاكه ترسانة نوويّة، وقدرات عسكرية هائلة، فكان سقوط جدار برلين في عام 1989، نهاية بحله بعد عامين.
شكّل انهيار الاتحاد السوفييتي في مطلع التسعينات، وتفرُّد الولايات المتحدة بقيادة العالم، تغييرًا جذريًّا في “بُنية القوة” في المشهد الدولي.
وكان لا بُدّ للولايات المتحدة من إعادة صياغة مفهومها للقوّة، ليتناسب مع هذا الواقع الجديد.
ونظّر الرئيسان الجمهوريّان؛ جورج دبليو بوش (الأب)، وجورج دبليو بوش (الابن) لمبدأ “فائض القوة” و”الحروب الاستباقية” الذي تمّ استنادًا إليه، “تفريغ فائض القوة الأميركية” على نحو مُفرط؛ حيث شهدنا في عهد الرئيس بوش الأب العمليات العسكرية في بنما، وحرب الخليج الثانية (حرب تحرير الكويت) في 1991.
ثمّ في عهد الرئيس بوش الابن، جاءت أحداث 11 سبتمبر 2001، لتشعل حروب “المحافظين الجدد” التي تكلّفت بحسب بعض المصادر الأميركية أكثر من 3 تريليون دولار، في محاولةٍ لبناء جدارٍ عازلٍ أمام الصّين (القوة الصّاعدة في النظام الدولي، والخصم الجديد آنذاك للولايات المتحدة) في غرب آسيا، وآسيا الوسطى.
وكانت مظاهر الصّراع في أعلى هرم السُّلطة العالمي قدْ تراجعَت مؤقّتًا في عهد الرئيس بيل كلينتون الذي شكّل محطّةً فاصلةً بين عهدَيْ؛ بوش الأب وبوش الابن، خاصّة بعد اقتراح كلينتون على الصّين: “السياسة لنا، والاقتصاد لكم.” إذْ ترأّس كلينتون أطول فترة من التوسُّع الاقتصادي في زمن السّلم في التاريخ الأميركي، ووقّع على قانون اتفاقيّة التجارة الحرّة لأميركا الشماليّة.
لقد آمن الرئيس كلينتون بـ”قوّة السلام”، وتبنّى فكرة “الحلّ الشامل” للقضية الفلسطينيّة في الشّرق الأوسط، فأحيا إرث الرئيس جيمي كارتر في اتفاقية كامب ديفيد، وشهِدَ توقيع اتفاقية أوسلو بين الرئيس ياسر عرفات، والرئيس إسحاق رابين في 13 سبتمبر 1993.
كما شهِدَ توقيع اتفاقيّة السّلام الأردنيّة – الإسرائيليّة المعروفة باسم “اتفاقية وادي عربة”، بين الملك الراحل الحسين بن طلال، والرئيس إسحاق رابين في 26 أكتوبر 1994.
لكن لحظة الرئيس كلينتون كانت للأسف لحظة عابرة في تاريخ الإستراتيجيا الأميركية، والمفهوم الأميركي للقوّة؛ إذ عُزل من منصبه بتاريخ 19 ديسمبر 1998 على يد مجلس النوّاب الأميركي، ليتولّى الجمهوريون زمام السلطة مرةً أخرى، عبر الرئيس جورج بوش الابن الذي وقعَت هجمات 11 سبتمبر الإرهابية بعد ثمان أشهر فقط، من تولّيه المنصب، فاستجاب لها بما أصبح يُسمّى لاحقًا “مبدأ بوش”، والذي تضمّن إطلاق حملة “الحرب على الإرهاب” التي شملت الحرب على أفغانستان عام 2001، والحرب على العراق في عام 2003.
أرهقت حروب “المحافظين الجدد” العَبثيّة، الاقتصادَ الأميركيّ، وألحقت أضرارًا بالغة بـ”القوة الناعمة” الأميركيّة.
وقد لا يكون من المُبالغة القول بأنّها أدخلت الولايات المتحدة في حقبة من “التيه الإ ستراتيجي” في ما يتعلّق بـ”مفهوم القوّة”.
وتطبيقاتها في السياسة الخارجية استمرّت لعقدين متتاليين ظلّت خلالهما تعيش سنوات من “ردود الأفعال”، بدلًا من امتلاك رؤية إستراتيجية شاملة؛ فكان عهد الرئيس باراك أوباما بمثابة “ردّة فعل” مُتطرّفة على تلك الحِقبَة، وكان عهد الرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى بمثابة “ردة فعل” على عهد أوباما، لتأتي ولاية الرئيس جو بايدن الوحيدة أيضًا كـ”ردة فعل” على عهد ترامب.
وعلى الرّغم من عدم اتفاق الإستراتيجيّين على وجود عقيدة خاصة بالرئيس أوباما حول مفهوم “القوة الأميركية”، إلّا أنّ البعض اعتبر خطاب أوباما في (ويست بوينت) مايو 2014، بمثابة إفصاحٍ عن عقيدة خاصة؛ إذْ أكد في الخطاب أنّ “الولايات المتحدة ستستخدم القوة العسكرية من جانب واحدٍ، فقط عندما تتطلب مصالحنا الأساسية ذلك،” ولكنها ستلتزم بـ”حشد الشركاء لاتخاذ إجراءات جماعية” في مواجهة التهديدات غير المباشرة، والأزمات الدولية.
ويجادل البعض الآخر بأنّ عقيدة “التّعدُّديّة الأخلاقيّة” تعكس اهتمام أوباما بالفيلسوف رينهولد نيبوهر الذي دعم السياسة الخارجية الأميركية التدخليّة، لكنه حذّر من الغطرسة، وسوء التقدير الأخلاقي.
ذهب أوبامًا بعيدًا في ردّة فعله على “المُحافظين الجُدد”؛ فتبنّى إستراتيجية “التوجُّه شَرْقًا”، وقلّل من قيمة الشّرق الأوسط الإستراتيجيّة، وأظهرَ عدمَ تقديرٍ للعلاقات الأميركية مع حُلفائها الإقليميّين، وهاجم دولًا ذاتَ دور محوريٍّ في المنطقة والعالم مثل المملكة العربية السعودية.
وأكثر من ذلك، دخل أوباما دهاليز الإسلام السياسي إبّان حقبة ما يُسمّى بـ”الربيع العربي”، ووقّع الاتفاقيّة النوويّة لعام 2015 مع إيران، وأطلقَ يدَها في منطقة الشرق الأوسط، فأدخل في حقبة مظلمة عُرفت بـ”عصر الميليشيات”.
ولعل الإنجاز الأوحد لأوباما في بَسْط القوة الأميركية، هو اغتيال زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي؛ أسامة بن لادن.
مهّدت حقبة أوباما الطريق لعودة الجمهوريين إلى سدّة الحكم في انتخابات 2016.
وجاء مرشّح الجمهوريين هذه المرّة من خارج السياقات التقليديّة التي عرفتها الولايات المتحدة؛ إذْ كان الرئيس دونالد ترامب بمثابة انقلاب أبيض على المؤسّسات، والسّياسات التقليديّة.
عكَسَ الرئيس ترامب مسارات أوباما، واتّبع أجندة “أميركا أولًا”، وسحَبَ الولايات المتحدة من المفاوضات التجارية للشراكة عبر المحيط الهادئ، ومن اتفاقية باريس للمناخ، ومن الاتفاق النووي الإيراني، وأطلق حملة “الضغوط القصوى” في وجه إيران، وأمر باغتيال جنرالها، قاسم سليماني، وأعاد الاعتبار لتحالفات واشنطن الإقليمية في الشرق الأوسط، ورمّم العلاقات مع الحلفاء، وقاد تحالفًا ناجحًا ضد الإرهاب؛ ما مكّنه من تقليص الحضور العسكري الأميركي في المنطقة، بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، واغتيال زعيمه أبوبكر البغدادي.
لكنّ ترامب بدأ حربًا تجارية مع الصين، انتُقِدت على نطاقٍ واسعٍ، ولم يُحرِزْ تقدُّمًا بشأن نزع السّلاح النووي الكوري الشمالي بالرغم من لقائه ثلاث مرات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، واعترف ترامب بالقدس عاصمةً لإسرائيل مُخالفًا بذلك قرار الأمم المتحدة الذي يَعْتَبرُ المدينة جزءًا من حلّ الدولتين.
كان رد فعل الرئيس ترامب على جائحة كوفيد–19بطيئًا، وتجاهل العديد من توصيات المسؤولين عن الصحة؛ ما شكّل نقطة ضعفٍ رئيسية في حملته الانتخابية للولاية الثانية، وفتحَ المجال لعودة الديمقراطيين مجدّدًا إلى سدة الحكم في البيت الأبيض عبر الرئيس جو بايدن.
وشكّلت مرحلة الرئيس بايدن فترة انتقالية، استهدفت استعادة اللحمة الوطنية التي قال الديمقراطيون إنّها بدأت تتمزق في عهد ترامب. لكنّ حقبة بايدن انتهت إلى إخفاقات كبيرة على مستوى الإدارة الأميركية للعالم، خاصة في ما يتعلّق بالحرب في أوكرانيا، وغزة.
إذْ وقفت الولايات المتحدة على أعتاب مفترق طرق خطير، بين الانزلاق إلى حرب عالمية، أو عبور النفق باتجاه نظام عالمي جديد أكثر استقرارًا.
كما وقف النظام العالمي برمّته في مفترق طرق بين الأحادية القطبية الأميركية، ومحاولات إعادة إنتاجها من جهة، وشكلٍ غيرِ واضحِ المعالم من التّعدُّدية القطبية التي تنشدها القوى الدوليّة المناهضة للأحادية القطبيّة الأميركيّة.
وعلى الرغم من إقرارِنا باستمرار التفوُّق الأميركيّ الواضحِ على المستوى العالمي، إلّا أننا لا يُمكن أنْ نتجاهل أيضًا حقيقةً ساطعةً، هي أنّ الولايات المتحدة تُواجه اليومَ مُعضِلةً مُرَكّبةً على ثلاثة مستويات: معضلة على مستوى النموذج السياسي، ومعضلة على مستوى الإستراتيجية، ومعضلة على مستوى القيادة.
وستنعكس هذه المعضلات بالنتيجة على “القوة الشاملة الأميركية”، وتحكمُ اتجاهات صانع القرار الأميركي في كيفية التصرُّف بهذه القوّة.
ومعروف أنّ علم السياسة، إنما هو تعبيرٌ عن “القوّة” أولًا، ثم “القرار” ثانيًا، والذي يعني كيفية التصرُّف بالقوّة، أو سلوك المُمْسِكين بزمامها.
لم يُظهر الرئيس ترامب في ولايته الأولى رغبةً، أو ربّما مقدرةً على التّنظير السياسي، والإستراتيجي، وقدّم نفسه بدلًا من ذلك، كرجل عمليّ، وقويّ، قادر على مُواجهة المشكلات، وحلّها.
لكنّه يبدو أكثر رغبةً في التعبير عن “عقيدة سياسية” في ولايته الثانية.
كما يبدو ترامب أكثر استعدادًا من سلفِهِ بايدن لقبول مبدأ “محيط التأثير” الذي يستند إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مرافعته حول أوكرانيا.
وهو مبدأ شبيه إلى حدٍّ كبير بـ”عقيدة مونرو” التي التزمت بها الولايات المتحدة على مدى المئتي عام الماضية.
وقد عبّر ترامب صراحةً خلال حملته الانتخابية عن تفهُّمه لمخاوف روسيا من توسُّع الناتو على حدودها؛ ما قد يخلقُ أساسًا لانتهاء الحرب في أوكرانيا.
وتُتّهم واشنطن بازدواجية المعايير في هذا الموقف، ومواقف أخرى مشابهة كثيرة، وبينما يُظهر الرؤساء الأميركيون عادةً حساسيّةً تجاه هذه الاتّهامات، ويسعون إلى تبريرها، يبدو الرئيس ترامب محايدًا في أحسن الأحوال، إن لم نقل: إنه يؤكّد وجود ازدواجية المعايير هذه، في مواقف عديدة.
كرّر الرئيس ترامب عبارة “السلام من خلال القوة” في تصريحاته حول إنهاء الحرب في أوكرانيا وغزة.
وهي ليست عبارة جديدة في العلاقات الدولية، بل قديمة جدًا، اشتهر باستخدامها العديد من القادة بدءًا من الإمبراطور الروماني هادريان في القرن الأول الميلادي، وحتى الرئيس رونالد ريغان في ثمانينيات القرن العشرين.
ويرتبط هذا المفهوم بالواقعيّة السياسيّة، وأنّ قوة السّلاح هي العنصر الأساس لتحقيق السلام.
وهي أيضًا عنوان كتاب عن خطة الدفاع التي وضعها برنارد باروخ، المستشار السابق للرئيس فرانكلين روزفلت لشؤون الحرب العالمية الثانية، نشرته دار (فاراروستراوس ويونغ) للنشر عام 1952.
وفي عام 2011، رفعت مؤسسة مجلس الأمن الأميركية؛ وهي منظمة محافظة صغيرة غير ربحية في ولاية فلوريدا، دعوى قضائية للمطالبة بحقها في استخدام العبارة كعلامة تجارية لها.
لقد أسّست حروب “المحافظين الجُدد” لحقبةٍ من “التّيه الإستراتيجيّ”، شهدنا خلالها استمرارًا لـ”سياسات ردود الأفعال” امتدّت لأكثر من عقدين متتاليين.
وتبدو الولايات المتحدة اليوم بأمسّ الحاجة إلى بلورة عقيدة جديدة للقوّة الأميركية.
وفي هذا الوقت بالذّات، ظهرت أطروحة الرئيس ترامب حول “السلام من خلال القوة” باعتبارها مخرج الولايات المتحدّة من هذا الضياع الإستراتيجي. لكنّها – كما يتّضح في سياق هذا المقال – ليست أطروحةً جديدةً على الإطلاق، لا في السياسة الأميركية، ولا في العلاقات الدولية، فهل يمنحها الرئيس ترامب خلال ولايته الثانية أبعادًا أو مضامين جديدة، بحيث يمكن الحديث عنها مستقبلًا باعتبارها عَقيدة أميركيّة جديدة؟.
نقلا عن العرب