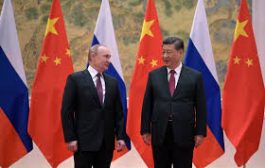غسان عبدالخالق
كاتب أردني
في كل أقطار العالم المتقدّم خلايا تفكير. وفي كل خليّة تفكير هناك عُضو (عاشر) مهمته الرئيسة تتمثّل في مخالفة ما أجمع عليه سائر الأعضاء، حتى لو قالوا إنّ الشمس تطلع من الشرق!
ورغم أنّ هذه الأقطار المتقدّمة تعرف حق المعرفة، أنّ الرجل العاشر يضطلع بدور وظيفي روتيني في معظم الأحوال، إلا أنها تحرص كل الحرص على إدامة هذا الدور في كل خلاياها؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إدراكاً منها لمدى حاجتها إلى هذا الدور في الأزمات والمنعطفات والتحوّلات الحاسمة.
ورغم كل ما يبوء به لاعبو هذا الدور من سمعة سلبية – فهم أصحاب النظّارات السوداء تارة وهم المتخصصون في رؤية النصف الفارغ من الكأس تارة أخرى – ومع ضرورة التذكير بأنّ أي فرد من أفراد خلية التفكير، مرشّح للاضطلاع بدور الرجل العاشر – تبعاً لموقع وموقف ورؤية هذا الفرد للقضية المطروحة – فإنّ خلايا التفكير لا توجد في القطاع الرسمي فقط؛ بل توجد أيضاً في القطاع الخاص والقطاع المدني. كما أنها لا توجد في الحقل السياسي فقط؛ بل توجد أيضاً في سائر الحقول، بما في ذلك حقول الإعلام والفن والرياضة والدعاية والإعلان.
ومن نافل الحديث القول بأنّ المعسكر الرأسمالي – رغم كل تناقضاته البنيوية والتاريخية – قد حسم معركته المصيرية مع المعسكر الاشتراكي – رغم كل منهجياته الديالكتيكية – بفضل تمسّكه الشديد بدور الرجل العاشر، الذي أثبت على الدوام أنه الأقدر على قرع جرس الإنذار في الوقت المناسب، وخاصة عندما تهيمن الرؤى الوردية على أجواء صناعة القرار، وبسبب تخلّي المعسكر الاشتراكي عن دور الرجل العاشر، إلى درجة الإقدام على تصفية كل من حدّثته نفسه بالتطوع لممارسة هذا الدور، ولو جزئياً أو شكلياً.
ومع ضرورة التذكير مرة أخرى، بأنّ بعض ما يُسند من بطولات لممثلي الدور العاشر في العالم المتقدم، لا يخلو من مبالغة أو ميل إلى الأسطرة أحياناً، فإنّ تقهقر وتائر التنمية؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في معظم أقطار الوطن العربي، يعود في المقام الأول إلى الاستهانة الشديدة بدور الرجل العاشر في أحسن الأحوال؛ لأن واقع الحال يؤكد أنّ خلايا التفكير ليست موجودة أصلاً! وحتى لو وجدت فهي صورية مؤقتة تهدف لرفع العتب عن كواهل صناع القرار لا أكثر.
ولعل ما شهدته بعض أقطار الوطن العربي من انتفاضات شعبية عارمة تحت مسمى (الربيع العربي) أكبر دليل على افتقار دوائر صنع القرار فيها، إلى القدرة على التنبؤ واستباق الحدث وتوفير الحلول والبدائل.
والمضحك المبكي في واقع أحوال معظم الأقطار العربية، أنّ الحديث عن أهمية الحوار والحق في الاختلاف وضرورة احترام الرأي والرأي الآخر ناهيك بتمجيد التفكير خارج الصندوق، يتناسب عكسياً مع ما يجري في مطابخ صنع القرار؛ من حيث الإصرار على مواصلة الانفصال عن الواقع، عبر الخطابات والشعارات الإنشائية والرومانسية التي عفى عليها الزمن، حتى في أكثر معاقل النظم الشمولية جموداً.
ومما زاد ويزيد الطين بلة على هذا الصعيد، أنّ معظم المؤسسات الخاصة والمنظمات الأهلية، قد التحقت هي الأخرى بركب الانفصال عن الواقع، عبر تقليد أو إعادة إنتاج معظم خطابات المؤسسات الرسمية، بل إنها تتجاوز المؤسسات الرسمية أحياناً، على صعيد المبالغة في تجميل الواقع وضخّ ما لا يعد من الآمال والتوقّعات المثالية، بغض النظر عما تصرخ به الأرقام والحقائق والمؤشرات.
إننا ندرك حقيقة أنّ إحراز التقدّم الشامل في الوطن العربي، ليس رهناً بفكرة هنا أو ملاحظة هناك، وأنه مهمة تاريخية طويلة المدى، تتطلّب ما لا يُعد ولا يُحصى من التراكمات الكميّة والنوعيّة، لكن التواطؤ على إفراغ وتفريغ الحياة العامة من قارعي الأجراس، مثّل وسيظل يمثّل، أبرز أسباب وأعراض التقهقر المأساوي العربي في القرن الواحد والعشرين.
ولولا أننا لا نريد تصعيد مشاعر الذنب لدى بعض قرّاء هذا المقال، لاستفضنا في الحديث مثلاً عن زرقاء اليمامة التي بادرت لتحذير قومها من زحف جيوش الأعداء ولم يصدقوها؛ فأحاط بهم الأعداء بعد أيام وأفنوهم بعد أن اقتلعوا عيني زرقاء اليمامة. ولاستفضنا في الحديث أيضاً عن نصر بن سيّار الذي استمات في تحذير الأمويين من مغبة الاستهانة بالخراسانيين دون جدوى، حتى اضطر إلى القول :
أرى خلَل الرماد وميض جمر
ويوشك أن يكون له ضِرامُ
فإن النار بالعيدان تُذكى
وإن الحرب أوّلها كلامُ
أقول من التعلّل ليت شعري:
أأيقاظٌ أميةُ أم نِيام؟!
وأما بخصوص حَمَلَة الأجراس قبيل سقوط بغداد في أيدي المغول، وقبيل سقوط مدن الأندلس، وقبيل هزيمة 1948 وهزيمة 1967… فإن الحديث يطول لأنه ذو شجون.
نقلاً عن حفريات