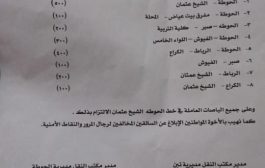محمد علواني
حين أعلن نيتشه نظريته الشهيرة في «هكذا تكلم زرادشت» في العود الأبدي، ظنه الناس مخرفًا، وُوجهت الفكرة بالرفض والدحض من كل الفلسفات والتيارات، غير أن الواقع/ التاريخ أبى إلا أن ينصف المفكر الألماني الأكثر موهبة ووحدة.
تقول نظرية العود الأبدي، باختصار، ليس إن كل ما بدأ يعود، فهذا تفكُّر أخروي لم يكن الفيلسوف الألماني معنيًا ولا مشغولًا به، وإنما أن هذه اللحظة نفسها هي نسخة من لحظة سابقة، وأنها ستظل تتكرر إلى الأبد.
هكذا لا ولن يحمل التاريخ جديدًا، اللحظة التي أكتب فيها هذا الكلام ستكرر أبدًا، هذا الشعور الذي تشعر به في يوم خريفي ستظل تشعر به في مثل هذا اليوم من كل خريف … إلخ.
وحين تمعن النظر في تاريخ الفكر لا يسعك إلا الاعتراف بأحقية فردريك نيتشه، فهاك الحداثة، على سبيل المثال، أقامت أسسها على العلم والتقدم والتنوير، وأرست الثورة الفرنسية مبادئ ثلاثة: الحرية والإخاء والمساواة، ثم زلق التاريخ في هوة سحيقة، أو قل عاد إلى سابق عهده.
فقبلت ما بعد الحداثة – من باب الحرية، الخصوصية، احترام الآخر … إلخ – كل ما رفضته الحداثة، وانزلقت الدول في نزعة قبائلية حديثة، حتى كأن التاريخ كلب يعود فيلعق رجيعه، أو حية تأبى إلا أن تأكل ذيلها.
ما طردته الحداثة من الباب أرجعته ما بعد الحداثة من الشباك، أليس مثيرًا للدهشة أن يشهد المقدس (التصوف والروحانيات بشتى ألوانها واليوجا وما إلى ذلك) ازدهارًا في عصر ما بعد الحداثة؟
ثمة تفسير لهذه الظاهرة، بعيد طبعًا عن القول إن ما بعد الحداثة سمحت لجميع الأفكار بأن تعثر لنفسها على موطئ قدم في عالم يموج بالأفكار موجًا. جزء من هذا التفسير يعود إلى الجانب النفسي.
ولست أنوي خوض النقاش الذي سوَّد به المفكرون صفحات كثيرات للإجابة عن سؤال: هل الإنسان كائن ميتافيزيقي أم لا؟ ولكن المهم أن نفهم أن لظروف هذا الزمن دورًا كبيرًا في اختراع أنماط تدين جديدة وأشكال مختلفة من المقدس بعضها يجاور الآخر طالما أن الأمر شخصي بامتياز.
المقدس والفراغ
ولكن، وكتمهيد لمسألة «دوران المقدس» التي نحن بصدد تحليلها وبسط القول فيها، أولى بنا أن نشير إلى جدلية أخرى من الجدليات الكثيرة التي تحكم هذا العصر، ألا وهي جدلية الفراغ/ الانشغال.
نحن جميعًا في الواقع منشغلون، ولكن اللافت أن وقت فراغنا نقتله قتلًا، وجزء كبير من انشغالنا وتشتتنا أننا لا نحسن إدارة وقتنا، ومن ثم نلقي بوقت الفراغ في هوة سحيقة من مشاهدة التلفاز أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي … إلخ.
بهذا المعنى قد نفهم قول عالم الاجتماع جيل ليبوفتسكي حين قال: «الفراغ هو الذي يحكم الآن، لكنه فراغ لا يمثل مأساة أو نهاية للعالم»(1).
غير أن هذا ليس ما يلفت في مسألة الفراغ تلك، وإنما ما يجب أن يسترعي الانتباه هو أن الفراغ يحيل دومًا على مقدس وحضارة أيضًا، فحين كان الإنسان الأول لديه من الوقت ما يكفي – كان لديه في الحقيقة فائض وقت وفائض قوة – اخترع أنماطًا وألوانًا من المقدسات، وصنع أيضًا حضارة. ألقِ فقط نظرة على أقرب معبد فرعوني قديم لتتأكد من صحة هذا الرأي.
إن ما نود قوله إن فراغ الفرد الحديث، وخواءه النفسي أيضًا، أحد العوامل الحاسمة التي تقوده، حتى من غير وعي منه، إلى الارتماء في أحضان المقدسات المخلتفة.
ولقد كان جيل ليبوفتسكي محقًّا، حين لفت إلى أن الحاجة إلى إلغاء الذات أو إثبات أنفسنا كذوات فاعلة في العالم، وأن التسامح الأقصى مع النفس أو هشاشتها اللامنتاهية(2) كل ذلك في بوتقة نسخة جديدة من التصوف أو قل إن شئت «الدروشة ما بعد الحداثية».
وربما عاذرة الإنسان في ذلك رغبته في العثور على أنس وصحبة، فلما لم يجدها بين البشر رحَّلها إلى مقدس من المقدسات (ولي من أولياء الله الصالحين، مقام من المقامات، ممارسة اليوجا … إلخ)، لا سيما وأن لهيب الوحدة لا يستعر في عصر الازدحام، ولقد وصفت هذه المسألة أوليفيا لاينج في كتابها «المدينة الوحيدة» بأبلغ وأخصر عبارة ممكنة حين قالت: «معًا ولكن فرادى»(3).
وتلك مسألة أخرى لا يتسع المقام لبسط القول فيها، ولكن المدينة بحد ذاتها أحد أكثر تجليات الوحدة والفراغ والخواء، وها هو جيل ليبوفتسكي يعبر عن الأمر قائلًا:
إزاء هذا كله لن يجد الإنسان المعاصر من باب مفتوح سوى باب المقدس، والأولياء، والممارسات الغارقة في الذاتية، ولا غرابة إن قلنا من جيل ليبوفتسكي إن النرجسية هي أكثر سمات هذا العصر وأكثر جلاءً، فإزاء كارثة معممة، يجد مبدأ «أنا ومن بعدي الطوفان» تربة خصبة للنمو والازدهار.
النرجسية وارتخاء الرهانات الأيديولوجية
حيال هذا الاستغراق التام في الذات، والنزوع نحو نمط معين من النرجسية، يحدث أمران: تنهدم الحياة الاجتماعية – النرجسية درجة صفر من الحياة الاجتماعية – وثانيًا يمَّم الإنسان شطر المقدسات، طالما أنه قد أدار ظهره للمجتمع وشخوصه وأفراده.
يقول جيل ليبوفتسكي: «تعمل النرجسية على تهدئة الغابة الإنسانية؛ من خلال إلغاء المراتب والهرميات الاجتماعية؛ وعبر التخفيف من الرغبة في أن يكون الواحد محل إعجاب غيره من نظرائه. إنها ثورة عميقة صامتة في العلاقة بين الأشخاص»، فما يهم الآن هو أن يكون الإنسان نفسه على الإطلاق وأن ينمو بمعزل عن معايير الآخر.
لقد أصبح النجاح الظاهر والجري وراء الاعتراف الشرفي يفقدان من قوتهما الإغرائية؛ وصار فضاء التنافس بين الناس يترك مكانه تدريجيًّا لصالح علاقة عمومية محايدة حيث الآخر المُفرَّغ من أي سماكة؛ لم يعد عدوًّا ولا منافسًا وإنما غير مبالٍ ومنزوع الجوهر على شاكلة شخصيات»(6).
يحلُّ التراخي محل كل شيء، لا هدف ولا غاية سوى «تكبير الدماغ»، وأن ينعم الإنسان مع نفسه، لا غاية سياسية، ولا اجتماعية، ولا أي مسعى آخر غير تزجية الأيام بأقصى متعة ممكنة وبأقل تكلفة أيضًا.
اللامبالاة ظاهرة من ظواهر هذا الزمن الكبرى، بل هذه مفارقة، جزء كبير من أفعال الناس لا دافع لها سوى اللامبالاة، أبرز هذه الأفعال الالتجاء إلى صور متنوعة؛ الديانات الشرقية أو إعادة إحياء فسلفات قديمة، ولا هدف من ذلك سوى القدرة على تحمل هذا الجحيم اليومي.
وبصدد وضع كهذا، لا تجد مذهبًا أو غاية يتمسك بها الناس أو ينافحون عنها، الذات هي الحصن الوحيد الذي يتمسك الإنسان به، وفي ذلك قتل لكل موضوعية، ووأد لكل ما هو اجتماعي.
دروان المقدس: الروحانية المقلوبة
يغيِّر المقدس شكله لكنه لا يختفي ولا يزول، فـ «لقد تطوعت الروحانيات لتلائم عصر السوق الممتاز والخدمة الذاتية؛ واجتاح الدوران والزعزعة مجال المقدس كما فعل مع مجال العمل والموضة: قد يمضي الواحد أوقاتًا كمسيحي، وبضعة أشهر كبوذي، وبضع سنوات كمريد للإله كريشنا أو المهراجا جي»(7).
تلك ظاهرة غريبة بحق، وإنما تتأتى غرابتها من وجهين: الأولى أن المرء لا يستقرُّ على وِجهة، فهو دائم الترحال بين الروحانيات والمقدسات، والثاني: أن المقدس قادر على تغيير خصائصه وسماته ليتناغم مع عصر عنوانه المادية ورفض المقدسات.
يقول صاحب كتاب «عصر الفراغ»: «لا شيء أغرب في هذا الزمن الكوكبي مما نسميه «عودة المقدس»؛ إذ تلقى الفلسفات والديانات الشرقية كالطاوية البوذية والباطنية والتقاليد الأوروبية، القبالاء الفيثاغورية «الثيوصوفيا»، الخيمياء، نجاحًا، كما أن هناك إقبالًا كثيفًا على دراسة التلمود والتوراة فى المدارس الدينية اليهودية؛ وتكاثرًا للطوائف»(8).
لا شك أن ذلك قد يعدُّ انسدادًا في أفق التنوير وأزمة في نسق الحداثة الفكري؛ حيث إعلاء العقل والتقدم والتنوير، وربما – وهذا وارد أيضًا – تكون الحداثة قد اعتراها الشك في نفسها، وعجزت عن تقديم حلول لمشكلات الإنسان المعاصر.
فتركته يعود أدراجه ثانية إلى الأفكار والتصورات التي قامت الحداثة نفسها على نفيها والحط من شأنها، أعني الميتافيزيقا والتفكير الماورائي وشتى صنوف وممارسات الدروشة الروحية.
ولئن كان دوران المقدس شيئًا غريبًا، وربما لا يستسغيه التأمل الأولي، ولكن يرى فيه جيل ليبوفتسكي مكملًا لمنطق ما بعد الحداثة – القائم أصلًا على التلفيق وتجاور ما لا يمكن تجاوره من أفكار وتصورات – إذ تعني هذه العودة توسيع نطاق الخيارات والممكنات أمام الحياة الخصوصية؛ ومن خلال إتاحة «كوكتيل» فرداني من المعنى الملائم لعمليات الشخصنة.
نقلاً عن “إضاءات”