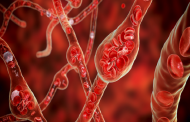يخلص بيجوفيتش إلى أن ثمة عنصر روحي/ إلهي/ سماوي في تكوين الإنسان ويقرر ما قرره هيجل: إن الإنسان باعتباره إنسانا فإن الدين جوهري بالنسبة له وليس شعورا خارجيا عن طبيعته.
وفيما سعت الفلسفة الوضعية –مستندة على العلم المادي- لتقريب الإنسان من الحيوان عبر نظرية “التطور”، إما بالتقليل من شأن المكون الروحي أو نفيه، فإن أشياع النزعة الروحية من الفلاسفة أمثال برجسون وتليار تصدوا لتلك النظرة، وتعد “الفلسفة البرجسونية” من أشهر فلسفات القرن العشرين في موقفها النقدي من العقلانية والعلموية، كما أنها –برأي بعض الباحثين- من أقدر التوجهات الفكرية التي ناهضت النزوع المادي، ودافعت عن أهمية الإيمان الديني، وفلسفة برجسون نفسها تعد من أهم مصادر بيجوفيتش، خاصة كتابه التطور الحي، كما ذكر في موضع سابق.
حينما تنظر الفلسفة المادية لتاريخ الجنس البشري كعملية تقدم وتطور ماديين، فإن بيجوفيتش الذي قرأ تلك الفلسفة جيدا، كما وقرأ لأصحاب النزعة الروحية بما يكفي لمحاججة الفريق الأول، يستنتج أن أحدا لم يفسر لمَ امتلأت حياة الإنسان البدائي بالعبادات والأسرار والمحظورات، ويتساءل: لماذا نسب الإنسان الحياة والشخصية لكل الأشياء المحيطة به من أحجار ونجوم وأنهار وغيرها؟ ومن هنا نجده يستنكر على الإنسان الحديث محاولة اختزال كل شيء في ما هو مادي وآلي.
ويستشهد بيجوفيتش على الحضور الفاعل للروح في تكوين الإنسان الذي أنتج أعمالا ذات صلة بالعبادة والدين والمعتقدات التي لم يخل منها تاريخ البشرية، بملاحظة بلوتارخ: “قد نجد مدنا بلا أسوار، أو بدون ملوك أو حضارة أو مسرح، ولكن لم يَر إنسا ن مدينة بدون أماكن للعبادة والعُب اد”، وكذلك ما قاله برجسون: “لقد وُجدَت ولا تزال حتى الآن مجتمعات إنسانية بدون علم ولا فن ولا فلسفة، ولكن لم يوجد مجتمع إنساني بدون دين”.
أما الطيب بوعزة فيقرر أنه “لم يسبق أن انتظم وجود بشري دون بلورة رؤية دينية أو رؤية فلسفية ميتافيزيقية”.
يلقي بيجوفيتش نظرة عامة على الأديان السماوية، ويستخلص أنها جميعا “تسلم بجلاء لا لبس فيه بمساواة جميع البشر باعتبارهم مخلوقات لله، وحجر الزاوية في الأديان المنزلة “الأصل المشترك” لجميع البشر، ومن ثم المساواة المطلقة بينهم، كوان لهذه الفكرة تأثير جوهري على جميع التطورات الروحيةوالأخلاقية والاجتماعية للجنس البشري”.
وفي حين يدعو لدراسة العلاقة بين فكرتي المساواة والخلود، يستنتج أن النظم الدينية والأخلاقية التي لا تؤمن بالخلود، أو لديها فكرة مشوشة عنه لا تؤمن بالمساواة، لأنه “إذا لم يكن الله موجودا فإن الناس غير متساوين”.
كلما تعزز الإيمان بالخلود كفكرة دينية باعثها الإيمان بالله، تتجلى مظاهر التسليم بالمساواة بين بني البشر كفكرة أخلاقية شغلت حيزا من التوجيهات الدينية والمبادئ الإنسانية، انطلاقا من وحدة الأصل الإنساني، ورفضا لكل معايير المفاضلة على أسس الجنس أو العرق أو اللون أو غيرها.
وعن صلة الأخلاق عامة بفكرة الخلود والإيمان بالله يرى بيجوفيتش أن الأخلاق كظاهرة واقعية في حياة الإنسانية لا يمكن تفسيرها تفسيرا عقليا، وفي هذا حجة للدين، لأن السلوك الأخلاقي يفقد قيمته ومعناه إلا بوجود فكرة “الخلود” التي تعني الحياة الخالدة وعالم آخر غير هذا العالم، وأن الله موجود، وهنا يكون لسلوك الإنسان وأخلاقه معنى ومبرر.
وفي موضع آخر يخلص إلى أن “جميع معل مي البشرية، سواء كانوا أنبياء، كموسى وعيسى ومحمد ) عليهم السلام (، أو غير أنبياء، مثل كونفشيوس وجوتاما بوذا وسقراط وكانْط وتولستوي ومارتن بوبر وهم يمثلون أحقابا من الزمن تمتد من القرن السادس قبل الميلاد حتى العصر الحالي )النصف الثاني من القرن العشرين( جميعهم علموا البشرية الأخلاق نفسها” .
ويذهب أبعد من هذا حين يقف على جدلية العلاقة بين الدين والأخلاق مؤكدا أنه “لا يمكن بناء الأخلاق إلا على الدين” ، مع الإشارة إلى أنهما ليسا شيئا واحدا، ف”الأخلاق كمبدأ، لا يمكن وجودها بغير دين، أما الأخلاق كممارسة أو حالة معينة من السلوك، فإنها لا تعتمد بطريقٍ مباشر على التدين.
والحُجة التي تربط بينهما ماعا هي العالم الآخر، العالم الأسمى، فلأنه عالم آخر هو عالم ديني ولأنه أسمى، فهو عالم أخلاقي.
وفي هذا يتجلى استناد كل من الدين والأخلاق أحدهما إلى الآخر، كما يتجلى استقلال كل منهما عن الآخر .
التزام المرء بالأخلاق مثلما قد يكون جزءا أصيلا من التزامه الديني، فإن ارتكابه – في بعض الحالات – مخالفات أخلاقية لا يعدو أن يكون تعبيرا عن التزام بالدين نفسه الذي يدعوه للتمسك بالأخلاق، وكما كانت أخلاقيات المسيح السامية نتيجة مباشرة لوعي ديني على الدرجة نفسها من القوة والوضوح، يلاحظ بيجوفيتش أيضا أن محققي محاكم التفتيش الذين قاموا بعمليات الاضطهاد الديني كانوا أي ا ضا مخلصين لعقيدتهم الدينية، وليس في ذلك تجنيا على الحقيقة، فأحد الذين تصدوا لمهمة كتابة تاريخ الغرب كتب:
“ومن المحتمل أن التعذيب الذي كانت تمارسه محاكم التفتيش كان يستهدف في وقت ما، مصلحة الضحايا على أساس أن العذاب الدنيوي في هذا العالم قد يُخل ص الروح من اللعنة الأبدية” .
ومن الناحية التاريخية، يرى بيجوفيتش أن الفكر الأخلاقي من أقدم الأفكار الإنسانية، ولا يسبقه سوى الفكر الديني، وقد التحم الفكران ماعا خلال التاريخ. ففي تاريخ علم الأخلاق، لم يوجد عملياا مفكر جاد لم يكن له موقف من الدين، إما عن طريق استعارة الضرورة الدينية كمبادئ للأخلاق، أو عن طريق محاولة إثبات العكس.
ولذلك، يمكن القول بأن تاريخ علم الأخلاق بأكمله قصة مت صلة لتشابك الفكرين الديني والأخلاقي.
وهو إذ يرى في المسيحية مثلا بارزا للتآلف الكامل والنسب القوي المتبادل إلى حد الوحدة بين دين عظيم وأخلاق عظيمة، يشير إلى الفارق في المسيحية بين عيسى المسيح كأب للمسيحية من جهة، وبولس كأب للكنيسة من جهة ثانية، حيث جاء الأول بالأخلاق المسيحية، وأدخل الثاني اللاهوت المسيحي، ويذهب إلى أن تأرجح الكنيسة في العصور الوسطى بين فلسفتي أفلاطون وأرسطو كان نتيجة للتناقض نفسه، رائيا أن تعاليم المسيح أقرب إلى فلسفة أفلاطون بينما اللاهوت أقرب إلى فلسفة أرسطو.
والشيء نفسه لاحظه فريدريك يودل في كتابه “تاريخ علم الأخلاق”، إذ يقول: فيما يتصل بالحياة العملية نجد أن تعاليم المسيحيين الأوائل كما عبر عنها الإنجيل، كانت مختلفة عن تعاليم الكنيسة التي جاءت بعدها ابتداء من لاهوت بولس كما كانت مختلفة عن التعاليم الأخرى في العالم سواء اليهودية أو الوثنية.
يقترب بيجوفيتش في نظرته للأخلاق وصلتها بالدين والميتافيزيقيا من أفلاطون الذي يصفه ب”رائد علم الأخلاق” المستندة إلى الفكر الديني، خاصة في إشارته إلى البراهين الميتافيزيقية مقابل البراهين الأنثروبولوجية، في اتساق متكامل مع فكرته القائلة بالوجود السابق للأشياء في عالم سماه عالم المثل، حيث تكون كل معارفنا في هذا العالم مجرد تذكر لما وجد من قبل في عالم المثل، والأمر ذاته يأتي مطابقا لفكرة الخلود حسب بيجوفيتش الذي يرى أن تأملات أفلاطون الأخلاقية قادته إلى موقف ديني.
ولم يقف الاستنتاج عند أفلاطون لكنه يصل إلى الفيلسوف العربي ابن رشد الذي نقل بعض كتب أفلاطون وأرسطو وفلسفتيهما من اليونانية إلى العربية، ومنها أفاد فلاسفة أوروبا فيما بعد، ويصفه بيجوفيتش بالفيلسوف الإسلامي العظيم، مشيرا إلى نظرته المض منة في ترجمة “جمهورية أفلاطون”، ومفادها أن الأخلاق هي جوهر الدين الكوني.
أما القرآن الكريم فيورد أكثر من خمسين نصا تتضمن “الذين آمنوا وعملوا الصالحات..”، إما لفظا أو معنى، في توكيد واضح على ضرورة اقتران الدين ممثلا هنا بالإيمان، والأخلاق التي يعبر عنها ب”العمل الصالح”.
ويكشف القرآن في بعض المواضع عن علاقة عكسية بين الإيمان الديني والأخلاق، إذ تقول الآية 29 من سورة آل عمران:” لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم “، ومضمونها أن الأعمال الصالحة وأفعال الخير هي الطريق المؤدي للإيمان وليس العكس، والمعنى وفقا لبيجوفيتش: “افعل الخير تصبح مؤمنا، وليس آمن لتصبح خي را”. ور دا على سؤال من يبحث عن محبة الله، جاء الجواب القرآني: “قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّه “. )آل عمران: 25.
وإذا ما سأل الإنسان كيف يقوي إيمانه؟ فإن الإجابة: “افعل الخير تجد الله أمامك”، وهو معنى قول الرسول لعبدالله بن عباس: “احفظ الله تجده تجاهك”. ويُقصد ب”احفظ الله” الالتزام بمكارم الأخلاق إجمالا.
*من بحث: منظور بيجوفيتش في التوفيق بين الدين والفلسفة- فؤاد مسعد- مركز نماء للدراسات*