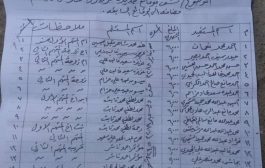أمين الزاوي كاتب ومفكر
عبر التاريخ الإنساني ظلت الحروب مادة خصبة للكتابة الروائية والشعرية والمسرحية والسينمائية والموسيقية، إن زمن شقاء الإنسان هو من خلّد الكتابة، ربما أكثر من زمن أفراحه، وعلى ذلك تأسس لدينا ما اصطلح عليه بـ”جماليات القبح” أو “جماليات الشر والشرير”، وهي تلك الكتابة التي تحول القبح والشر إلى جمال ومتعة خالدة وعابرة للأزمنة وللثقافات واللغات، وذلك هو السر الغريب في فلسفة الكتابة الإبداعية.
نقرأ رواية عنيفة عن الحرب القبيحة فنقول، ما أجملها! ما أروعها! نتتبع حياة شخصية شريرة إلى أقصى الحدود فنعلق، مدهشة هذه الشخصية!
نقرأ رواية عن وباء فتاك أصاب قوم بلد فتأسرنا، وتظل صورة الموتى في قبورهم الجماعية وفي صمتهم ملتصقة بذاكرتنا وبذاكرة القراء، وذلك هو سحر الكتابة.
وتظل صورة الحرب القذرة عالقة في ذاكرتنا أكثر فأكثر، كلما كانت الكتابة التي ترسمها متميزة بقدرة على التشريح الجمالي والفلسفي لأن مثل هذا البقاء في الذاكرة الإنسانية الفردية والجماعية هو عبارة عن نداء الضمير الإنساني أو ما بقي منه حياً ضد شر الحرب.
ولأن الحرب هي مصدر من مصادر الخوف من الموت لذلك هي لصيقة بالكتابة التي وجدت للدفاع عن الحياة وعن الخلود، يحدث هذا منذ زمن حرب طروادة وحرب البسوس وحرب الـ 100 عام وصولاً إلى حرب الإبادة في غزة.
ولأن الحرب مرتبطة في جوهرها العنيف أيضاً بحلم الحرية الجماعية (الاستقلال) تظل خزاناً للكتابة والكتاب، إذ إن سعي الكتابة الجادة، في نهاية الأمر، هو المرافعة عن قيمة العدل والمساواة ومقاومة الظلم والذل والنهب والإهانة والجوع.
ولأن الحرب مرتبطة في الذاكرة البشرية بصور الخراب العمراني والتهجير البشري، فهي وشم لا يمحى من الكتابة التي هي بدورها تريد أن تكون أثراً لا يزول من خلال الحفر في أسرار وجود الإنسان بعيداً من أي أسلوب دعوي أو تحريضي.
وفي تاريخ الكتابة الإنسانية الطويل والمعقد، بكل اللغات وفي كل الثقافات، تشكلت لدينا مكتبات عامرة بالكتب الخالدة والعالمية التي ارتبطت شهرتها بأهوال الحروب البشعة وشرور الإنسان ضد الإنسان وضد الطبيعة، وعلى رغم مرور القرون على ظهور بعض هذه العناوين، فإنها لا تزال تقرأ بكثير من الانتباه والاهتمام لأن الحروب لا يتغير مضمونها ولا يتغير إحساس المكوي بنارها.
وعلى رغم أن موضوع الحرب كتبت عنه نصوص كثيرة جداً، نصوص مبهرة خالدة في الرواية وفي الشعر، وأخرجت عنها أفلام مدهشة، فإن الكتاب لا يزالون يعودون لمثل هذا الموضوع والكتابة عنه بإحساس متجدد وكأن لا أحد تطرق إليه، ويرجع السر في ذلك إلى أن شقاء الإنسان أبدي يشبه الشقاء في أسطورة سيزيف.
اليوم، ونحن نعبر عتبة الربع الأول من القرن الـ21، ما زلنا نقرأ بشغف رواية “الحرب والسلم” لتولستوي وكأنها كتبت البارحة وهي التي صدرت (مسلسلة في جريدة روسية ما بين عامي 1865 و1867) ثم نشرت في كتاب عام 1869.
وإذا كان تولستوي كتب حرب نابليون بونابرت على روسيا عام 1812، فإن هذه الحرب لا تزال وبكل شراسة موقدة في كثير من مناطق العالم، وذهب نابليون وبقيت الحرب، أليست حرب روسيا وأوكرانيا ومن خلفها العالم الأوروبي فصل جديد في رواية “الحرب والسلم” لتولستوي تنتظر عبقرية كعبقرية تولستوي لكتابتها.
الحروب الفظيعة يحركها عادة الصغار، ثم يفغرون أفواههم حين تتحول إلى حريق يلتهم الغابة كلها ولا أحد يستطيع التحكم فيها، وقد لا ينتبهون إلا حين تأكلهم وهم موقدوها، ولا يزال الإنسان لم يحفظ الدرس جيداً، لذا يكتب عن الحرب التي انتهت في هذا المكان ليشعل آخرون حرباً جديدة في مكان آخر تنتظر كتاباً آخرين مقبلين.
نعم، تظل الحرب، بشرّها وقبحها، هي الدرس الذي لم يقرأه الإنسان منذ قرون لأنها الحال التي توهم بالانتصار الكاذب، لهذا ترانا اليوم نقرأ ونعيد قراءة “الحرب والسلم” وكأن تولستوي يعيش معنا في هذا الزمن الشرير الجديد.
ونتأمل لوحة غرنيكا الشهيرة لبيكاسو فنكتشف كيف تحولت الحرب الأهلية الإسبانية المدمرة إلى شهادة فنية تاريخية جميلة، حرب دموية جاءت على البشر والحجر التي دارت بين الجمهوريين، وقوات فرانشيسكو فرانكو المدعومة من قبل النازية الألمانية والفاشية الإيطالية، والتي جراءها قصفت مدينة غرنيكا في منطقة الباسك عام 1937 بالطائرات الألمانية والإيطالية، فدمرت على آخرها. وانتهت النازية والفاشية ورحل فرانكو وظلت لوحة بيكاسو درساً للإنسان في كل مكان عن شرّ الحرب التي لا تستريح، لكن الإنسان لا يرى، لذا فالألوان لا تزال ترسم وباستمرار فظاعة الحرب التي تشبه الوحش الخرافي الذي يظهر ها هنا أو ها هناك، برأس جديد كلما قطع له الرأس القديم.
كانت الحرب العالمية الثانية بكل مواجعها موضوعاً لآلاف النصوص الروائية الخالدة، في كل اللغات العالمية، ويمكننا ذكر بعض العناوين التي قرئت في لغات كثيرة وبالإحساس الإنساني ذاته، كـ”لمن تقرع الأجراس” أو “وداعاً للسلاح” لهمنغواي و”الثلج الحار” ليوري بونداريف عن معركة ستالينغراد و”الشرط الإنساني” لأندري مالرو و”المثقفون” لسيمون دي بوفوار و”طبل الصفيح” لغونتر غراس و”المنزل في الليل” لخوسي ساراماغو… مكتبات مليئة رفوفها بالروايات عن الحرب العالمية الثانية، وعلى رغم ما فيها من تشريح عميق لمآسي الحروب من موت ودمار وأمراض نفسية وكراهيات، فإن الإنسان الذي أشعلها لا يمر عليه وقت قصير حتى ينسى هذا الهلع الذي صنعه بيده ليعيد الكرة مرة أخرى وبأسلحة أكثر فتكاً وإجراماً.
ولم تسلم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ويلات الحرب، فعلى مدى الأعوام الـ100 الماضية، كانت الحرب وطواحينها هي العشاء المر لشعوب المنطقة، ولا تزال تتجرع ذلك حتى الآن، ومعها لا يزال الكتاب والمبدعون يتأملون هذه الحرب المتواصلة ويكتبون عنها الكتب فوق الكتب وكأنما تقع، للمرة الأولى، بدرجة الدهشة ذاتها وبسلّم الخوف نفسه وبصور التهجير والدمار ذاتها.
كانت حرب التحرير الجزائرية (1954-1962)، حدث هذا قبل أكثر من سبعة عقود، شرسة بكل معنى الشراسة، ولأنها كذلك فقد كانت الرحم الذي ولدت منه نصوص روائية خالدة باللغة الفرنسية في المرحلة الأولى لتلتحق بها الرواية بالعربية لاحقاً، يحتفظ “ريبرتوار” الآداب العالمية بروايات “نجمة” لكاتب ياسين، ومن يذكر “البحر” لمحمد ديب و”العصا والأفيون” لمولود معمري و”التلميذ والدرس” لمالك حداد و”اللاز” للطاهر وطار و”التفكك” لرشيد بوجدرة وغيرها. وعلى رغم جروح حرب التحرير التي انتهت عام 1962 فقد عاد الجزائريون لساحة الحرب ثانية بعد 30 سنة من انتهاء الأولى، وكأنهم لم يقرأوا تاريخهم ولم يطلعوا على أدبهم ولم يشاهدوا أفلامهم، وهكذا كانت الحرب الأهلية التي انطلقت في بداية التسعينيات لتدوم 10 أعوام، كانت وحشية بكل معنى الوحشية، وقد خلفت آثاراً مدمرة على بنية المجتمع المادية وعلى البنية النفسية للفرد وخلخلت نسق التركيبة الاجتماعية في الريف وفي المدينة على حد سواء، ومرة أخرى كانت الرواية حاضرة وكان الروائي شاهد عيان على هذه العشرية الدموية، وظهرت نصوص روائية كثيرة بالعربية والأمازيغية والفرنسية، كلها بمستويات جمالية متفاوتة وبوعي سياسي وفلسفي متفاوت أيضاً، ومن بين الروايات الأكثر تأثيراً باللغة الفرنسية نذكر “إذا ما أراد الشيطان” لمحمد ديب و”الحياة في المكان المناسب” لرشيد بوجدرة و”بم تحلم الذئاب” لياسمينة خضرا و”قسم البرابرة” لبوعلام صنصال وروايات أخرى كثيرة لنور الدين سعدي وأنور بن مالك وعيسى خلادي وسليم باشي ومايسة باي وسليمة غزالي… وباللغة العربية للطاهر وطار وعبدالحميد بن هدوقة وأحلام مستغانمي وربيعة جلطي وبقطاش مرزاق والحبيب السائح والجيلالي خلاص ومحمد ساري وفيصل الأحمر…
الإنسان ينزف والكتابة كذلك، والشر يتجلى بقرف ومنه تتجلى الكتابة الفاتنة! تلك هي المفارقة العجيبة في الكتابة الخالدة!
كانت هزيمة حرب عام 67 إعلاناً عن سقوط القناع عن الخطاب القومي العربي المنتفخ بعبارات الانتصار وأناشيد التمجيد، ومعها بدأ مسلسل ضياع فلسطين يتجلى بوضوح حلقة بعد أخرى، ليستمر إلى يومنا هذا، وبين هزيمة عام 67 وحرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 73 والحرب الأهلية الطائفية في لبنان والحرب في سوريا التي انطلقت عام 2011 وحرب غزة 2023 التي لا تزال مشتعلة، وبإبادة لم يعرفها تاريخ البشرية من قبل، لم تنَم الحرب يوماً ولم يعد المحارب لسريره ولو لليلة واحدة.
وفي خضم هذا الخراب المتواصل والشر المعمم وبحر الدموع، ظلت الكتابة تغرس ريشتها في محبرة الدم المسفوك بغزارة، فظهرت الرواية الفلسطينية لتكتب فجيعة شعب موزع بين الشتات ومرارة يوميات المخيم من جهة وبين مطحنة الحرب والاستيطان والعنصرية من جهة أخرى، فكانت روايات غسان كنفاني ويحيى يخلف ومحمود شاهين وجبرا إبراهيم جبرا وإميل حبيبي وسحر خليفة رشاد أبو شاور وإبراهيم نصرالله وربعي المدهون… وسجل الروائيون اللبنانيون بشاعة الحرب الأهلية اللبنانية في نصوص مدهشة لكل من إلياس خوري وهدى بركات ورشيد الضعيف ونجوى بركات، وعبده وازن في روايته الأخيرة “الحياة ليست رواية” وغيرهم، وعلى رغم الرقابة والمنع اللذين عاناهما الأدب في سوريا فإن كثراً من الروائيين كتبوا الحروب العمياء التي عاشها هذا الشعب المقهور من أمثال حنا مينة ونبيل سليمان وخليل صويلح وخليل النعيمي وسليم بركات وخيري الذهبي وهوشنك أوسي وسليم الرز وهيفاء بيطار وغيرهم.
جميع هؤلاء الكتاب خلدوا أسماءهم من خلال كتابة جماليات الشر، شر الحرب التي حولوها إلى حكاية لا تنسى وشخوص لا يسقطون من الذاكرة، بعضهم في صورة المقاوم وبعضهم الآخر في صورة المتخاذل.
اليوم، ونحن نتابع مراسيم تتويج فيلم “صوت هند رجب” للمخرجة التونسية كوثر بن هنية بجائزة “الأسد الفضي” في مهرجان تورونتو السينمائي العالمي في دورته الـ 82 لعام 2025 الذي يروي قصة واقعية أليمة لمقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب البالغة من العمر خمس سنوات في قطاع غزة، وما مصيرها إلا صورة لمصير آلاف الأطفال في حرب إبادة تشنها إسرائيل على المواطنين العزل، نتابع التتويج هذا ونحن نقف على مدى الاحتفاء الإيجابي الذي قوبل به الفيلم في الإعلام الأميركي والأوروبي ومن قبل النخب الفنية والسينمائية، فندرك أن الأدب والفنون هي أسلحة ناشرة لقيم الخير حتى وهي تقدم لنا صوراً عن شرور الحرب وقبح دمارها ورعبها، نتأكد أن الفن والأدب سلاح لبناء الإنسان المعطوب وإعادة ترتيب قطع “بازل” الحلم المشتت لديه، وأن الفن طاقة ضد الشر حتى وهو يحفر في موضوع الشر نفسه، حتى وهو يدير مواجع الحرب الضروس ويقلبها، تلك الطاحونة البشرية التي لم تتوقف الكتابة عن تناولها منذ قابيل وهابيل.
نعم، إن الشر موضوع مغرٍ للكتابة الخالدة التي تتحول إلى مقاومة للقبح والشر وهي تكتبهما، وتلك هي أسرار النصوص العظيمة!
نقلا” عن أندبندنت