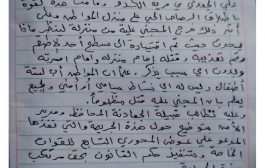حافظ مراد
في أحد الأودية السحيقة بين شعاب محافظة ريمة، وتحديدا في عزلة “بكال” بمديرية مزهر، نشأ منصور حميد علي البكالي، شاب نحيل البنية، حادّ النظرات، لا تكاد ترى على وجهه ابتسامة صافية.
ابن فلاح بسيط لا يعرف من الدنيا سوى محراثه وعرق جبينه، يحلم أن يرى ولده يوماً يحمل اسمه بفخر، يرتقي في سلم الحياة، ويعود إليه يوماً بثمار العلم.
لكن منصور، ومنذ نعومة أظافره، لم يكن يحلم بالإرتشاف من منابع المعرفة الصافية ليحقق حلم أبيه،بل كان يحمل في صدره طموحاً من نوعٍ مختلف؛ طموحاً لا يشبه بيئته، ولا رائحة الأرض التي عاش بين ترابها، طموحاً سيئاً، يُشبه الجوع لا الشغف، يحلم بالسلطة، وإن كانت في الظل.
حين غادر منصور قريته في عام 2008، أخبر والده بوعد زائف وأمنية خائبه حيث قال لوالده : “سأذهب لأعمل في السعودية، وسأرسل لك المال، وأحقق حلمك بمنزل جديد.”
لكنه شدّ الرحال إلى صعدة، حيث وكر الجماعة الحوثية، ومصانع العقول التي تُشكّل على هوى الوليّ الفقيه .
لم يكن يعلم والده أنه ذهب إلى مهاوي الردى وكهوف الضلال ليتتلمذ على أيدي من يمسخون العقول المتبلده كي تصير أدوات طيعة في يد الجهل المنحرف.
هناك، قضى عامين متتاليين ينهل من فكر الجماعة، ويتشبّع بعقيدة تقدّس السلالة وتزدري سائر الناس.
تلاشت ما تبقت من البراءة في عينيه، وابتلع الظلام قلبه.
بعد عامين، عاد إلى صنعاء ليدرس الإعلام، لكن ليس ليُعلي الكلمة في سبيل الحق ، بل ليتقن فن التلاعب والتضليل بها.
لم يكن اختياره عبثاً؛ فالإعلام كان في نظره سلاحاً أمضى من البندقية، ووسيلةً لتزييف الحقيقة، وتوجيه العقول كما يُوجَّه القطيع.
وفي 2011، حين كانت الساحات تهتف بالحرية، كان منصور يقف خلف الكاميرا، لا لينقل الحقيقة، بل ليصوغ مشهداً يخدم أسياده.
عمل في مركز إعلامي حوثي بمعية ما يُسمّى “شباب الصمود”، وكان يصنع من الوهم أملا، وينسج من الكلمات عباءات كاذبة ليستر بها وجه الاستبداد.
كان يجيد التلوّن، يتحدث عن الكرامة بينما يسحقها، ويلهج باسم الحرية وهو يخنق أنفاسها، يفبرك الكلمات لصالح جماعة لا تؤمن إلا بالسمع والطاعة، ولا تفهم من الحرية سوى أنها فوضى يجب وأدها.
أُرسل منصور مجدداً إلى صعدة، ليشارك في حروب دماج وعمران، وحين اجتاحت جماعته صنعاء، تسلل منصور من وراء الكواليس إلى دائرة أوسع: جهاز الأمن الوقائي.
هناك، وجد منصبه الحقيقي، لا كإعلامي، بل كظلٍ يتبع الناس، يرصد أنفاسهم، ويتعقب المعارضين، يكتب تقاريره عنهم بدم بارد،، ويقترح الأسماء المرشحة للاختفاء، ويغتالهم دون رصاصة.
أُوكلت إليه مهمة استقطاب الإعلاميين والناشطين من أبناء منطقته – ريمة – فاستغل علاقاته، وزيّف الحقائق، وأغرى البعض بالدورات الثقافية، التي تبدأ بخطبة وتنتهي بربط العقل بالسلسلة، فكان كالذئب يلبس جلد الراعي، يقود الخراف نحو الذبح بابتسامةٍ مريبة.
في ريمة، مسقط رأسه، لم يعد منصور الفلاح.
صار “الأستاذ”، “الخبير”، “المثقف”… لكنه كان يعلم في أعماقه أنه مجرد عبد يظن نفسه سيداً، عبداً للسلطة وللوهم يعشق الذل ويأنف الحرية.
وحين وقف يوماً أمام الكاميرا ليتحدث عن ما أسماهم بـ “المرتزقة” من أبناء ريمة كانت صفحة وجهه تحكي لكل من شاهده أنه يكذب.
فـ”المرتزقة” الذين شتمهم هم أولئك الذين آمنوا أن لهم حقاً في حياةٍ كريمة، في عدالة لا تميز بين السيّد والخادم، في وطن لا يُحكم من الكهوف.
لكن الزمن لا يرحم، والجماعة لا تُكافئ الإخلاص… بل تستبدله.
بعد سنواتٍ من خدمةٍ مخلصة، بدأ منصور يشعر بأنه يزاح نحو الهامش.
قلّت اتصالاته، خفّت دعواته للاجتماعات، وتجاهله من كانوا بالأمس يشدّون على يده.
حلّ محلّه من هم أكثر حدّةً، وأقلّ تفكيراً، ممن يصلحون كأدوات صمّاء لا يثقلهم عبء السؤال ولا يزعجهم وخز الضمير.
أما في ريمة، فقد عاد غريباً بين أهله.
الذين صدّقوه يوما ما ثم نبذوه بقناعة مطلقه.
لم يعودوا يرون فيه ذلك “الإعلامي” الذي يقارع “العدوان”، بل مجرد جاسوس سقط قناعه، وغُدر به كما غدر بغيره.
صار لا يُدعى للمناسبات، ولا يُرد على سلامه، والأطفال يهمسون عند مروره: “هذا الذي كان يخبر عن جيرانه”، وأصبح اسمه مرادفاً للخيانة والخذلان.
لم يشفع له تاريخه في خدمة الجماعة، بل صار سبباً في عزله ونبذه.
ذات مساءٍ، جلس منصور على سطح منزل والده الطيني، ينظر إلى السماء الداكنة فوقه.
تذكّر المثل الذي قاله له أحد شباب ريمة الأحرار: “لو أمطرت السماء حرية، لرأيت العبيد يستظلون.”
ابتسم منصور بسخريةٍ حزينة، ومدّ يده إلى السماء، فلم يجد فيها مطراً… ولا حرية.
وجد نفسه فقط وحيدةً في الظلّ الذي اختاره طوعاً، ظناً منه أنه ظِلْ السادة كما هي أمنيته… فإذا به ظل عبد قد باع كرامته، وفقد آدميته إلى أبد الآبدين.